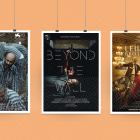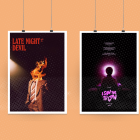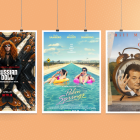إلى حد كبير نحن أمام فيلم جيد؛ فمن ناحية الكتابة، فالنص هنا يحمل بداخله أبعادًا مختلفة قادرة على أن تجذب انتباه المشاهد إلى الحكاية، والشخصيات مكتوبة بصدق، ولكل شخصية ماضٍ يثقل ظهرها، مع براعة الأداء المميز الذي قدمه كامل الباشا في دور الأب، والابن أحمد مالك الذي يحافظ هنا على مستواه الفني القوي الذي يقدمه مؤخرًا في أفلامه، ولو أنه أصبح يقدم الشخصية نفسها في أعماله مؤخرًا، ومايان السيد التي قدمت دورها دون تكلف.
المدينة الرمادية
وعلى مستوى الإخراج، فنحن أمام مخرج جاد يعرف جيدًا ما يريد قوله، ولديه الطرق والأدوات التي تمكنه من تقديم أفضل أداء. قدّم صيام كادرات جميلة جدًا ومناسبة لأجواء العمل، وبذكاء شديد اختار الإسكندرية لتكون معبرة عن هذا العالم، وهو اختيار عبقري؛ فمن ناحية، الإسكندرية اختيار مناسب جدًا وتشبه شخصيات الفيلم، ومن ناحية أخرى، هو اختيار إخراجي ذكي من مخرج يدرك أن فيلمه لا يحمل الكثير من الأحداث، لذلك أراد أن يحافظ على انتباه المشاهد في كل مشهد عن طريق تقديم لوكيشنات جديدة على عينه لم يعتدها، كما لو كان اختار التصوير في القاهرة.
أضف إلى ذلك المونتاج شديد الحرفية من المونتير أحمد حافظ، مع الموسيقى التصويرية الرائعة، والصورة المميزة جدًا من مدير التصوير عمر أبو دومة.
كتب السيناريو مع المخرج محمد صيام السيناريست أحمد عامر، الذي يملك حرفية عالية في كتابة عوالم الديستوبيا والعوالم القاسية، كما فعلها في فيلم «ريش» مع المخرج عمر الزهيري.
تستند قوة «كولونيا» إلى البنية النفسية لشخصياته أكثر من الأحداث ذاتها. فالأب، الذي يؤديه كامل الباشا بأداء عميق ومؤلم، ليس مجرد والد تقليدي، بل تجسيدٌ لجيلٍ من الآباء حمل عبء المسؤولية حتى تحول الحب لديه إلى سلطة، والرغبة في الحماية إلى قيدٍ من الخوف. في كل نظرة من عينيه، يشعر المتفرج بثقل الماضي ومرارة الفقد؛ كأن الأب يُعاقَب على أخطائه القديمة بمجرد وجوده.
أما الابن الذي يجسده أحمد مالك، فهو شابٌّ مأزوم بين الرغبة في التمرد والخشية من أن يكون نسخة من أبيه. يؤدي مالك الشخصية بتوازنٍ نادر، يجمع بين العنفوان والضعف، بين التوتر الداخلي والسكينة الظاهرة. كل حركة منه تكشف شيئًا من هذا الجيل الذي يريد أن يتحرر من الموروث، لكنه يظل مشدودًا إليه كمن يقاوم ظلّه.
وبين الأب والابن، تقف الحبيبة – التي جسدتها مايان السيد – كصوتٍ ناعمٍ للحياة، تحمل وعدًا بالحبّ والحرية، لكنها هي الأخرى لا تسلم من قسوة الواقع، فوجودها يتحول إلى أملٍ مؤجل لا يتحقق. هنا يبرع صيام في استخدام الكاميرا كضمير بصري للشخصيات؛ فهي لا تراقبهم فقط، بل تنفذ إلى داخلهم، تحاصرهم في لقطات ضيقة حين يختنقون، وتفتح الإطار حين يلوح أفق الخلاص.
أما الإسكندرية التي اختارها فضاءً للأحداث، فتغدو كائنًا حيًا يتنفس مع الشخصيات ويشاركهم التوتر ذاته؛ مدينة رمادية، رطبة، تتقاطع فيها أصوات البحر مع صمت الجدران، كأنها مرآة تعكس اضطراب الداخل الإنساني أكثر مما تعكس وجه المكان.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة عنوان الفيلم «كولونيا: رائحة أبي» مفتاحًا رمزيًا دقيقًا لقراءته. فالعطر الذي يضعه الناس لإخفاء روائحهم ليس سوى استعارة لمحاولتنا الدائمة لإخفاء العفن الداخلي خلف مظاهر الأناقة والرقي. كل شخصية في الفيلم تضع «كولونيا» ما، سواء كانت سلطة أو تبريرًا أو حبًا زائفًا.
الجميع يحاولون التجمل، بينما الحقيقة الفاسدة تظل تعبق في الهواء. ومن هنا يتجاوز الفيلم حدوده الدرامية إلى تأملٍ فلسفي في طبيعة الإنسان والمجتمع: كيف نرث الخوف جيلًا بعد جيل؟ كيف نعيد إنتاج القهر تحت أسماء مختلفة؟ وكيف نحيا بأقنعة أنيقة كي لا نشم رائحة أنفسنا؟ هذه الأسئلة لا يطرحها الفيلم صراحة، لكنه يجعلها تتسرب خلال تطور الأحداث.
وبهذا الشكل، ينجح صيام في تحويل حكاية تبدو بسيطة إلى قصيدة بصرية عن الميراث الإنساني، وعن الموت بوصفه استمرارًا لا نهاية؛ فالأب يموت ليبدأ الابن في مواجهة ذاته، والموت ليس ختامًا بل بداية إدراكٍ قاسٍ بأننا لا نتحرر من آبائنا، بل نكررهم بطرقٍ أخرى.
الخاتمة
يقدم محمد صيام في «كولونيا» تجربة ناضجة إلى حد كبير على مستوى الفكرة والتعبير، فيلمًا إنسانيًا لا يبحث عن الإثارة المصطنعة، ولا يلهث وراء الميلودراما، بل يواجهنا بواقعنا النفسي العاري دون زينة. مع وجود بعض السلبيات والأخطاء التي قد تكون أثرت على تجربة المشاهدة، لكن في النهاية نحن أمام فيلم يعلن ميلاد مخرج نضمه إلى جانب الأسماء الموهوبة الأخرى التي ظهرت على الساحة مؤخرًا، وهو جيل مبشّر جدًا.
«كولونيا» عملٌ عن الأبوة والخوف، عن الحب المكسور والحرية الموءودة، عن الميراث الذي نحمله في دمنا مهما حاولنا أن نغسله بالعطور.
 البوستر التشويقي لفيلم «كولونيا» وبطلا العمل أحمد مالك وكمال الباشا
البوستر التشويقي لفيلم «كولونيا» وبطلا العمل أحمد مالك وكمال الباشا