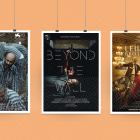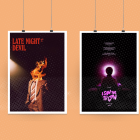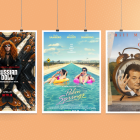فن
الجواهر الخفية من السينما المصرية: الحب الذي كان
«الحب الذي كان» عملٌ مدهش لم يُنصفه التاريخ كما يليق، لكنه يظل شاهدًا على أن السينما قادرة على جعل العاطفة قدرًا أكبر من مجرد قصة تُروى.
 مشاهد من فيلم «الحب الذي كان»
مشاهد من فيلم «الحب الذي كان»
يبدأ الفيلم بوصول (مها) إلى منزل رجل نكتشف أنه عشيقها (سامي).. مها متزوجة، لكنها في الوقت نفسه تميل إلى الدكتور سامي؛ تقابله، وتقبّله، وتقضي معه أوقاتًا كثيرة مثيرة في الخفاء. في أثناء وجودها مع سامي تتغلب عليه شهوته، فتمتنع مها، وترحل منزعجة، وتعود إلى بيت زوجها محمّلة بمشاعر متضاربة، يبدو على وجهها الحيرة والضياع. في حين أن كمال زوجها يتحدث في الهاتف غير مكترث بها، تحاول هي طلب الاهتمام منه؛ تلتف حوله بهدوء، تحتضنه، تبحث بداخله عن الاهتمام، لكنه منغمس في مكالمة هاتفية تخص العمل.
عبّر المخرج الرائع (علي بدرخان) عن تلك البلادة التي تتملك زوجها كمال، وبيّن حالة الاشتياق والحاجة التي تمتلك مها ببراعة شديدة، حينما جعل الزوج يتحدث في الهاتف مشغولًا بعمله في حين أنه بين أحضان زوجته المشتاقة المتلهفة.
يتم دعوة مها وكمال زوجها إلى حضور حفل، تتفاجأ فيه مها بوجود عشيقها الدكتور سامي. يحاول كل منهما تجنّب لقاء الآخر حتى لا يُفتضح أمرهما، ولكن ما نعرفه كمشاهدين في هذه الحفلة أن العلاقة بين مها وسامي يعلمها الجميع! في الحفل تشك مها أنها حامل بعد أن تقيّأت (المشهد الذي قبله كانت مها قد سلّمت نفسها لسامي)، لتكون هذه هي الشرارة التي تُثير بداخلها ثورة على الوضع المفروض عليها.
خلال المتابعة يتخلل إلى عقل المشاهد بعض التساؤلات: كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ ومن أين بدأت الحكاية؟ من الذي أحبته مها أولًا؟ ولماذا وصلنا إلى هنا؟ ليبدأ الميهي ببراعة وحرفة شديدة الإجابة عن كل الأسئلة الدائرة في عقل المشاهد من خلال (فلاش باك). نكتشف أن صدفة جمعت بين مها والدكتور سامي في مكتبة الجامعة، تقابلا وتعارفا.. مها كانت تحب كمال منذ أيام الدراسة، لكن والدها رفض زواجها منه، فتتزوج مها من كمال؛ فهو الشخص المناسب اجتماعيًا. ترضى وترضخ مها للواقع، إلى أن يجمع القدر بينها وبين سامي من جديد، لتشتعل زجوة العشق المُطفأة أيضًا من جديد.
تثور مها على الوضع الراهن، وتطلب من زوجها الطلاق لتكون مع الرجل الذي أحبته، ولتُحيي الحب الذي كان. لكنها تواجه رفض أسرتها، وتواجه مجتمعًا كاملًا ليس له حديث إلا عن قصتها مع الدكتور سامي، ومن هنا يبدأ صراع مضنٍ تكابد فيه مها الضغوط والقيود حتى تسترد ذاتها عبر استرداد الحب الذي كان.
وفي الحقيقة تأسفت من عدم معرفتي بهذا الفيلم من قبل، ولولا كتابة هذا الكتاب واهتمامي بكل نتاج الميهي ما كنت شاهدته. وهذه من عطاءات الكتابة، وكثيرًا ما تعطي الكتابة للمهموم بما يكتب عنه معرفة لا يتحصلها غيره. والمؤسف أن الفيلم غير معروف، ولا يتم إذاعته في الفضائيات، وهذا حادث في كثير من الأفلام، والعجيب أنه يحدث مع أفلام مدهشة وعظيمة! فقد عانيت حتى وجدت الفيلم، وهو غير موجود حتى في المنصات الرقمية العربية! رغم أنه من أفضل ما قدّمه الميهي كسيناريست في نظري. وأظن أن لفت الانتباه إلى مثل هذه الأفلام دور النقاد والمحبين.
حالة فريدة متميزة
قدّم لنا بدرخان في أول أفلامه فيلمًا رائعًا بروح رومانسية شاعرية، وبلغة سينمائية متميزة، حتى إنه يصعب تصديق أن «الحب الذي كان» هو أول أفلامه! حتى إني عند مشاهدة العمل لأول مرة – ولم أكن شاهدته قبل ذلك – كان لديّ معلومة أن الفيلم من إخراج بدرخان، ولكن كذبت نفسي، وقلت لعلي أخطأت القراءة! ليس هذا الرجل هو نفسه مخرج «الكرنك» و«الراعي والنساء». ورغم تميّز هذه الأفلام، إلا أن هذا الفيلم أحسبه حالة فريدة متمايزة عن غيره من الأعمال التي قدمها بدرخان. حتى على المستوى التقني والفني أثبت الرجل نفسه بجدارة واستحقاق، ووضع اسمه ضمن الكبار من أول عمل. وقد فاز بدرخان بجائزة «جمعية نقاد السينما المصريين» كأفضل فيلم تم عرضه في ذلك العام.
أما عن رأفت الميهي، فهناك تطور مشهود في فيلمه هذا من خلال العمق الذي عالج به قصة تقليدية. بل يمكن اعتبار الفيلم بمثابة نقطة تحوّل في مسار الرجل، حيث طوّر من أسلوبه السينمائي ليكون أكثر تركيزًا على الصراعات الداخلية للشخصيات، وعلى المسائل النفسية والاجتماعية المعقدة، بعيدًا عن الصراع الظاهر بين الأفراد أو الطبقات الاجتماعية. غاص الميهي في الأبعاد النفسية والجوانية للشخصيات، كما أن الصراع الخارجي لم يغب، حيث وجدناه متجسّدًا في المجتمع الذي يحارب هذه العلاقة بشراسة.
كما أن اللعبة التي مارسها الميهي في أفلامه السابقة لم يتخلّ عنها في فيلمه هذا، وأنا أتحدث هنا عن طريقة السرد التي يحب الميهي أن يحكي بها دائمًا. فالفيلم به مشاهد (فلاش باك) نتعرّف من خلالها على خلفية العلاقة بين مها وسامي. الميهي ركّز على التطور النفسي للشخصيات. أبطال الفيلم يمرون بتحولات في شخصيتهم نتيجة للقرارات التي يتخذونها، وتظهر تفاعلاتهم مع الشخصيات الأخرى بشكل معقد، مما يعكس الصراع الداخلي الذي يعيشه كل فرد. بيّن الميهي كيف أن الحب قد لا يكون دائمًا سبيلًا للنجاة، بل قد يتحول إلى عبء؛ فالحب هو ما أوقع بهم في تلك العذابات المضنية.
بيّن أيضًا العذاب الذي يعانيه المُحب حينما يكون حبيبه ليس على نفس الدرجة من المحبة. وبيّن لنا كيف أن الحب لا يموت مهما مرّت السنوات ومهما طال السكوت؛ قد يخفت أحيانًا لكنه لا يموت، يتحول إلى جزء من روحنا، قد نتجاهله أو نحاول إنكاره، لكن في النهاية يبقى بداخلنا كذكرى عذبة لا تموت.
رمزية الأماكن والأحداث
برع الميهي في استخدام الرمزية لتوصيل المعاني العميقة من خلال الأماكن والأحداث التي تعكس تحولات الحالة النفسية للأبطال، مثل الأماكن التي يزورونها أو الأوقات التي يقضونها معًا، مما يضيف بعدًا ميتافيزيقيًا للفيلم، وهذه من الملامح الهامة التي ستبلغ نهاية نضجها فيما بعد في الأفلام التي سيتولى الميهي إخراجها بنفسه. وكأن الميهي يريد من ذلك أن يقول لنا إن الحب يتجاوز حدود الزمان والمكان.
في المكان الذي يتقابلان فيه – مها وسامي – يبدو بعيدًا ومنعزلًا عن العالم (كما رأينا ذلك في المشهد الأول)، وكأنهما يتقابلان خارج الواقع! فمن خلال هذه الأمكنة الميتافيزيقية يظهر الانفصال بين الحالة الشعورية داخل الشخصيات وبين واقعهما الذي يعيشانه.
فالأمكنة هنا ليست مجرد ديكور/خلفية اختيرت دون وعي، بل هي بمثابة فقاعة زمنية لا تشعر فيها الشخصيات بمرور الوقت؛ كأنه يتوقف في هذه اللحظات. كما أن هذه الأمكنة تعكس الصراع المستمر بين الخيال والواقع؛ فرغم أن الأبطال يحاولون العودة إلى بعضهما البعض، إلا أن العلاقة بينهما تتسم بالفقدان والتباعد، مثلما تتسم الأمكنة بوجود مسافة بين الأحلام والواقع. كما اتسمت أيضًا لقاءات الشخصيات بالظلمة؛ فالليل ميدان الأفكار والذكريات.
من النقاط التي برع فيها الميهي أيضًا، وتبيّن لنا مدى موهبته وإتقانه وصنعته، كيفية تعامله مع وقت الفيلم، وهي نقطة تميز لدى الميهي في كل أفلامه، ولكن هنا على الخصوص يبدو الأمر أكثر صعوبة، حيث إن القصة تقليدية مما قد يصيب المشاهد بالملل نتيجة ذلك، لكنه أجاد الأمر بحرفة شديدة، وبشكل يضمن استمرار الإيقاع السريع للفيلم رغم العمق العاطفي الذي يتطلبه السيناريو، من خلال مشاهد مليئة بالتوتر العاطفي، ومشحونة المشاعر، وسرد غير خطي ضد الملل الذي كان من الممكن جدًّا أن يتسرّب إلى المشاهد.
انعكاس الفيلم على حياة سعاد حسني
الفيلم ليس بعيدًا عن واقع عاشه علي بدرخان وسعاد حسني! جسدت سعاد حسني الدور بحس مرهف، انعكست الحُرقة التي بداخلها في نَن عينها أمام الكاميرا. قصة دسمة المشاعر، مربكة محيّرة كتبها (الميهي) بحس شاعر لا سيناريست! جسدتها سعاد كأنها تكتب مذكراتها؛ تشعر بأنها تحكي لك عن قصتها، تحكي بجسدها، بعينها، بحركتها أمام الكاميرا. ويا للعجب أنها فيما بعد قد مرت بما قصّته علينا!
جمعت مخرج العمل (علي بدرخان) و(سعاد) علاقة حب تكللت بالزواج لكنها لم تدُم. فبعد مرور 11 سنة طلبت سعاد الطلاق من زوجها الذي أحسّت منه الفتور. يقول بدرخان:
«مش قضية نزوة، وبدون ذكر تفاصيل، كل علاقة بيحصل لها فترات خفوت وده حصل فعلًا، أنا كرجل فنان عايز يبقى فيه حاجة دائمًا في الحياة ممتعة، وكانت عندي رغبة في التغيير، والله مش عارف بالضبط ليه حصل ده، لكن حصل، المهم إن الانفصال حصل بطريقة شيك جدًا ومن غير أي خناقات».
وبدأت علاقتهما منذ عمله مساعد مخرج مع والده في فيلم «نادية» (1969). تقول سعاد عن هذا اللقاء:
«التقيت به لأول مرة عندما كنت أمثل دور البطولة في فيلم نادية، وكان يومئذ يعمل كمساعد لوالده المخرج المرحوم أحمد بدرخان، فقد عرفني به والده ووجدته شابًا في غاية الأدب والتهذيب في مراعاته للأصول والبروتوكول عندما يسلم عليّ أو يتكلم معي، ورغم أنه شاب فقد كان يتصرف بأسلوب الرجال الناضجين». وكان الانطباع الأول الذي سيطر عليّ عندما رأيته هو إعجابي به وباحترامه للناس البسطاء، كما أنه غير مفتعل وشخص صادق، وعندما اعترف لي بحبه صدقته».
وسعاد في «الحب الذي كان» مختلفة؛ ظهرت بعيدًا عن صورة الفتاة الشقية المبهجة. يقول علي بدرخان عنها في حوار له مع بلال فضل:
«سعاد حسني يتم تقييمها خطأ بشكل عام، وأنا لا أحب ألقاب سندريلا وسيدة الشاشة ونجمة الجماهير، كل هذه الألقاب غلط، ويتحمل مسئوليتها الصحفيون. لما نتكلم عن سعاد حسني الممثلة فهي أم كلثوم التمثيل في الوطن العربي؛ هي أهم من ظهر على الشاشة من حيث التنوع والأداء والإمكانيات وأداء الشخصيات، كل شيء عملته على الشاشة. بعكس جميع من وقفوا أمام الكاميرا كانوا محدودين في جوانب معينة».
على كل، فإن العلاقة بين بدرخان وسعاد بدأت قبل الفيلم، وانتهت بعده. ورغم ما يحمله فيلم «الحب الذي كان» من نضج درامي وبراعة في تجسيد الصراع النفسي داخل إطار قصصي محكم، إلا أنه للأسف يظل من الأفلام المغمورة في مسيرتَي رأفت الميهي وعلي بدرخان، لا يحظى بما يستحقه من اهتمام أو تقدير. وقد جاء اختيارنا له ضمن سلسلة «الجواهر المخفية من السينما المصرية» إيمانًا منا بقيمته الفنية، وأملًا في أن يدفع هذا التناول القراء إلى اكتشافه أو إعادة مشاهدته بعين مختلفة؛ فهو عمل سينمائي ممتاز، ممتع، وعميق في آن واحد.