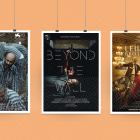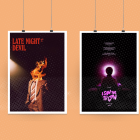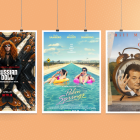١- الريشة.. استعارة الوجود العابر
الريشة التي تهبط في افتتاح الفيلم لا يمكن النظر إليها كعنصرٍ جماليٍّ عابر، بل بوصفها البذرة الأولى للمعنى، العلامة التي تفتح باب التأويل على مصراعيه. إنها ليست شيئًا يتحرك في الفراغ بغير قصد، بل صورة رمزية لتلك العلاقة الملتبسة بين الصدفة والمصير، بين هشاشة الكائن الإنساني وثقل العالم الذي يسقط فيه.
الريشة خفيفة بما يكفي لأن تتلاعب بها الرياح، لكنها في الوقت نفسه تمتلك حضورًا حقيقيًا يهبط في النهاية على قدم «فورست» كأنها وجدته مصادفة لتختبر به معنى الوجود ذاته. كأن الفيلم، من خلال هذا المشهد الأول، يقول لنا إن كل ما سيحدث لاحقًا محكوم بهذه الخفة: خفة المعنى، وخفة المصادفة، وخفة الكائن الذي يُلقى في الحياة دون أن يختار زمانه أو مكانه.
الريشة لا تعرف إلى أين تمضي، لكنها تمضي رغم ذلك، تحملها التيارات إلى وجهاتٍ متبدلة. هكذا هو الإنسان في العالم، كائنٌ منساق في تيارٍ لا يُدرك مصدره، يحاول أن يخلق من حركته المبعثرة سيرةً ذات معنى، أن يضع في العشوائية ترتيبًا داخليًا لا يراه أحد سواه.
ومن هذه النقطة، يصبح فورست غامب التجسيد الأكثر نقاءً لفكرة «الإنسان الملقى» ـ كما عبّر عنها الفلاسفة الوجوديون ـ الكائن الذي وجد نفسه هنا دون تفسيرٍ مُسبق، والذي لا يملك إلا أن يختبر الحياة كما تأتي، فيغدو فعله نفسه إجابةً على سؤال الوجود. لا يسعى فورست إلى تأمل معناه ولا إلى تفسير الأحداث، بل إلى خوضها حتى آخرها، فيصدق عليه أن «القَفز في الحياة أهم من فهمها».
حين يقول فورست في النهاية:
«I don’t know if we each have a destiny, or if we’re all just floating around accidental-like on a breeze... maybe both is happening at the same time.»
فهو لا ينطق بحكمةٍ متعالية، بل بحكمة البراءة: ذلك الإدراك الغامض بأن العالم ليس منظومة منطقية، وأن وجودنا ليس خطأً ولا ترتيبًا، بل حالة وسطى بين العشوائية والقصد، بين الريح التي تحملنا والاتجاه الذي نتخيله. الريشة ليست رمزًا للعجز، بل للقبول؛ قبول ما لا يمكن تفسيره، والرضا بحقيقة أننا ـ مثلها ـ نحيا خفافًا على حافة المجهول، نُساق إلى أماكن لا نعرفها، وربما في هذا التيه نفسه، تكمن الحرية التي لم نبحث عنها يومًا.
٢- الحياة كعلبة شوكولاتة: الحكمة في البساطة
حين نسمع جملة أم فورست الشهيرة:
«Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get.»
قد نظنها مجرد حكمة أمٍّ ريفيةٍ تسلي بها طفلها، لكنها في جوهرها تفتح نافذة على تصورٍ عميق للحياة، أشد عمقًا مما يبدو. فالحياة ـ كعلبة الشوكولاتة ـ لا تُكشف دفعة واحدة، بل تُقدَّم إلينا بقطعٍ مختلفة الطعم، لا نعرف إن كانت حلوة أم مُرّة حتى نعضّها. الفارق الوحيد أن الإنسان، بخلاف الطفل، يظل طوال عمره يحاول أن يتنبأ بما سيذوقه، وأن يختار الطعم مسبقًا، بينما فورست يترك نفسه للتجربة كما هي، يقبلها ببراءة، ويأكل الشوكولاتة دون خوفٍ من المفاجأة.
في هذه الجملة الصغيرة تتكثف الفلسفة التي يعيش بها فورست العالم: فلسفة القبول، لا بمعنى الاستسلام، بل بمعنى الانفتاح على ما لا يمكن توقعه. إنه نموذج لإنسانٍ يعيش اللحظة دون أن يطارد معناها، يدرك أن كثرة الحسابات لا تُحصّن الإنسان من الخيبة، وأن الحياة تُعاش لا لتُفهم، بل لتُختبر. فبينما يقضي الآخرون أعمارهم في تأويل الحياة وتبريرها، يمضي فورست بخفة مَن لم تثقله الأسئلة.
وهنا تكمن المفارقة العميقة: فوسط عالمٍ مضطرب مثل أمريكا الستينيات والسبعينيات ـ عالمٍ يتقلّب بين الحرب الفيتنامية، واغتيالات القادة، واحتجاجات الشوارع، وحركة الهيبيز، وانفجار الأيديولوجيات ـ يأتي فورست ككائنٍ نقي خارج هذا الصخب. وجوده ذاته يبدو كأنه رد هادئ على جنون العالم؛ فهو لا يتورط في الجدل، ولا يرفع شعارات، ولا يملك سردية سياسية أو دينية يختبئ خلفها. إنه يواجه الواقع بفطرته، كما لو أن صدقه الفطري أقدر على النجاة من أي منظومة فكرية.
بذلك يصبح فورست «نقيض الإنسان الأيديولوجي» الذي يفسر كل شيء ويُبرر كل شيء. ففي حين كان جيله ممزقًا بين الحرب والسلام، بين التمرد والامتثال، كان هو يعيش ببساطةٍ طفولية لا تعرف الانقسام. يشارك في الحرب لا لأنه يؤمن بها، بل لأنه طُلب منه ذلك. يحب جيني لأنها موجودة، لا لأنها تمثل فكرة. يركض لأنه لا يجد سببًا ليتوقف. كل أفعاله تتولد من الداخل، من استجابة تلقائية صافية للحياة.
وهكذا يتحوّل نجاحه ـ الذي يبدو في ظاهره سلسلة من المصادفات ـ إلى نوعٍ من النقد الضمني للعقل الأداتي الحديث، الذي يربط النجاح بالتخطيط والمهارة والذكاء. فورست يبرهن، دون أن يقصد، أن النقاء أحيانًا أبلغ من الذكاء، وأن الصدق مع الذات قد يفتح أبوابًا تعجز عنها الحسابات المعقدة. فالبساطة في عالمٍ مفرط في التعقيد ليست سذاجة، بل مقاومة صامتة: مقاومة ضد كل ما يحوّل الحياة إلى معادلة، والإنسان إلى رقمٍ في جدول المصالح.