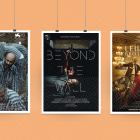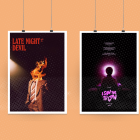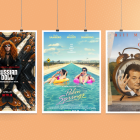فن
«وداعاً جوليا»: من السكون التاريخي إلى حيوية الإنساني
استطاع الفيلم أن يحقق نجاحاً تجارياً متجاوزاً كل التوقعات بنزوحه نحو الإنساني والفردي ليحقق تجربة مشاهدة منفتحة على تيمات مجردة على رغم خصوصيتها.
 مشهد من فيلم «وداعاً جوليا»
مشهد من فيلم «وداعاً جوليا»
تنجح السينما في تأطير الإشكاليات الكبرى ضمن نماذج داخلية أشد خصوصية، تضغط العمومي والجامع في بنية فردية مبطنة بذاتية عاطفية تتبع في تكشفها السينمائي لحساسية متفاوتة تجاه الذات والآخر، وتفصح باشتباكها عن الانغمار الفردي داخل السياقات الاجتماعية، سواء كانت فردية تتبع ترتيبات خاصة بحوادث شخصية، أو عامة تخضع لمسارات كلية تمس طائفة أو بلداً بشكل عام، حيث تشكل هاجساً جمعياً يتعرض له الفرد على حسب خلفيته الثقافية وتسلسل واقعه الحياتي.
تأطير العام داخل التجربة الفردية
في بعض الأحيان، تغرق المجتمعات في حمى التنافر، يتوهم الفرد بضرورة حماية الهوية الجمعية القائمة على صفات مادية أو مجردة، التي بالتبعية تخلق مجتمعاً متآلفاًــ متنافراً ومتوحداًــ متفرقاً يقوم على احتقار الخارجي وازدراء كل ما هو خارج سياقاته الآمنة، تصدر تلك الدوائر شعوراً بحتمية العزل والتفريق العنصري والعرقي، بحيث لا يسمح حتى إذا وجدت مساحة مشتركة؛ بأن ينخرط الأفراد لدرجة تتساوى فيها الرؤوس، فتنتج إلزامية أن يأخذ العالم وجهين متعارضين، أبيض أو أسود، فإذا توحد اللون؛ دخل العرق والدين ليقررا مدى التفريق، وإذا توحد الدين؛ ظهرت الطوائف المتعارضة، هناك دائماً طرف كاشف ينظر للصورة من الخارج، يؤيد وجود كفتين متعارضتين، لتتفاقم القضايا الداخلية إلى مستويات أعنف وأشمل.
وفي ظل حشد الموجات المحملة بمشاعر اضطهاد وعنصرية؛ وبطريقة عرضية؛ تولد بعض الحالات الاستثنائية، على مستوى التكوين وفي درجة اشتباكها مع الآخر، توفر مساحة للتساؤلات، وتفضي إلى رؤى إبداعية تحاول إدماج الحقيقي بالدرامي، لخلق تجربة لها خصوصية فيما تلعب في الداخل على تيمات مجردة لمشاعر وخصائص تتجاوز الفردي وتعبر نحو الآخر، خلق حساسية تجاه الطرف الآخر، مفعمة بالندم والحب والقهر، وهي تقنية سردية مفهومة لتأطير العام في قلب الفردي، وهذا ما يحاول فيلم «وداعاً جوليا» القيام به، خلق نوعاً من الانسجام بين طرفين يحملان آثاماً وفواجع ومحناً عرقية، إذ ينخرط في مساحة سينمائية تكشف إلى أي مدى يمكن أن يتقارب كلاهما في عالم ضيق ومحدود ولكنه كاف لتتحول النظرة الفوقية إلى مشاعر إنسانية، لأنه ببساطة يجد التيمات والموتيفات التي تجمع بين الشخصيتين داخل نقطة حميمية، كلاهما مقهور في سرديته الخاصة وتسلسله الاجتماعي، مجردتان من الإرادة الحرة، تابعتان لنموذج معين، منساقتان داخل تراتبية لها ظهير تاريخي ثقيل لا يمكن دفعه بسهولة، لذا فهو فيلم إزاحة، إزاحة الشخصيات وتوريطها في حيز أكثر تعقيداً من فكرة الرفض الأولي للأشياء.

مشهد من الفيلم السوداني «وداعاً جوليا»
العنف باعتباره استهلالاً حيوياً للحكاية
ينطلق محمد كردفاني، مخرج فيلم «وداعاً جوليا»، من العام إلى الخاص، ويتحرك من الخارج إلى الداخل؛ يفتتح الفيلم بمتوالية مشهدية تؤسس لمجتمع قائم على العنف، لقطات سريعة وصاخبة ترصد أعمالاً تخريبية لمجموعة تمارس العنف بشكل عشوائي داخل المكان، غليان سكان الجنوب المضطهدين الذي وصل إلى ذروته بعد اغتيال «جون قرنق» ــ زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ يتجسد داخل ممارسات تطبع تأثيرها على سياق الفيلم بشكل مبدئي.
يختار كردفاني الانطلاق من نقطة الزمانية حيوية؛ ليمنح فيلمه الزخم المطلوب لتوفير إثارة وحماس كافيين لإثارة فضول المشاهد حول ما يحدث، إنها نقطة انفجار وذروة أولية تسحب المشاهد داخل بلاد في أوج اضطرابها، بعدها يمسك كردفاني بالإيقاع، ويسقط عالمه الخارجي على شخوصه الداخلية، فينسحب إلى الداخل لنتعرف على أكرم (نزار جمعة)، أحد سوداني الشمال، المصابين بحمى السيادة العنصرية، يمكن تمييز خواصه بسهولة؛ شخص معمي بنظرته الفوقية ذات المرجعية الدينية والعرقية المتعصبة، ومن ثم نتعرف على زوجته منى (إيمان يوسف)، امرأة مقهورة داخل سياقات اجتماعية وذكورية تتعاطى معها كتابع وسلعة، تحب منى الغناء، وتذهب متنكرة لمتابعة فرقتها الموسيقية القديمة فيما ترتدي النقاب الذي يضمن لها التخفي الآمن، نعرف مع تسلسل الأحداث أن زوجها منعها من ممارسة الغناء بدافع الغيرة من صديقها.
في طريق عودة منى بالسيارة تصدم أحد أطفال الجنوبيين وتظن أنها قتلته، فتهرع بالسيارة فيما يطاردها والد الطفل على دراجته النارية، تتصل منى بزوجها لتستنجد به، وتصل إلى المنزل ولا يزال الجنوبي في ذيلها، ومن دون كثير من المقدمات أو الحديث، يطلق أكرم النار نحو الجنوبي، ويرديه قتيلاً، ومن هنا يتحول المسلسل بمقدماته التي تشي بعنف معلن ومبطن؛ إلى فعل وممارسات تطهيرية حتى بمجاراتها لكل العنف الكائن داخل المجتمع، فالمتوالية المشهدية التي تفصح عن العنف والتخريب، تنقلب إلى نموذج تكفيري يتجسد في شخصية منى، كمضاد لرؤى زوجها الأولية والساذجة، تغوص منى في هوة الذنب الذي اقترفته، وتلك الانفراجة العنيفة للمشاعر هي ما يدفع الأحداث للأمام، على رغم موجة الانمحاء والإزالة الكاملةــ فجأةــ لشخصية الرجل الجنوبي، الذي تؤخذ دراجاته النارية وينضم إلى عداد المنسيين، الذين يراهم الشماليون عبيداً ودخلاء بلا قيمة، تقابلها موجة أخرى عاطفية تقودها منى، بالبحث عن الشخص ذاته في سجلات الشرطة لتصل إلى زوجته جوليا (سيران رياك) وابنه دانيال، أي امتداده بالمعايير والتقاليد المحلية المتعارف عليها، وتعينها خادمة في منزلها الشمالي الفخم، لا تناديها بالعبدة أو الخادمة، بل تناديها باسمها، ويبدأ الفيلم بالتأسيس لجوليا باعتبارها شخصية، انطلاقاً من الاعتراف باسمها بصفتها إنساناً، وخلق مساحة مشتركة وأرض وسطى.

مشهد من فيلم وداعاً جوليا
نحو مساحة جديدة
من تلك النقطة يبدأ الفيلم بالإزاحة نحو مساحة مشتركة، تتبدى بوضوح من خلال السماح لجوليا وابنها بالسكن في غرفة خارجية ملحقة بالمنزل، وبعض المشاهد الأخرى التي تتبدى رد فعل واضحاً على عنصرية الزوج، حينما يسمح لها بالبقاء ولكنه يردف: «بس متحطش إيديها في الأكل» إضافة إلى تخصيص أطباق معينة موسومة بنقاط حمراء أسفل كل طبق، لتأكل فيها هي وابنها، فتأخذ منى كل الأطباق الموسومة وتمسح العلامات، في محاولة لإزاحة الكراهية؛ مدفوعة بذنب معلن وقهر يبطن اليومي، بيد أن كردفاني يصدر منى بصفتها شخصية مقهورة قائمة على الكذب باعتباره سلاحاً أولياً لمواجهة الطبيعة المحافظة والعنصرية للمجتمع، فالكذب عنصر أساس في تكوين الشخصية، يتبدى في ممارسات يومية متفاوتة الأهمية، بداية من إعداد الفطور والذهاب لحفلات موسيقية، مروراً بالوقائع الأولى للحادثة.
لذا فالكذب هو المفتاح الحقيقي لتفكيك الشخصية، باعتبارها آلية دفاع أولى تجاه زوجها الذي يقع على رأس المنظومة الهرمية للأسرة العربية؛ فالخداع هو الخط الأول، ولكن بعد الحادثة، تغير الأمر، أصبحت تكذب لا لتحرير ذاتها من القيود الذكورية والاجتماعية، ولكن مدفوعة بشعور عميق بالذنب تجاه الخطيئة الأولى، وتحاول حتى ولو بشكل غير مباشر تحرير الآخر، لأنها مشتبكة معه في إطار مركزي يهدد وجوده في الأساس، فالذنب هنا يتجاوز الألفاظ المجردة ويحتاج إلى حركة حقيقية لتطهيره.
العقدة الحقيقية في فيلم كردفاني تأتي من ارتكاب الفعل، فالسردية كلها حصيلة التورط الفعلي في الضرر الواقع على العائلة الجنوبية، لذا أشير مرة أخرى إلى مصطلح الإزاحة لمساحة مشتركة، فمنى لا ترتكز في بنائها بصفتها شخصية دامية على الأفعال الصدامية، بل تراوغها بالكذب والخداع والبقاء في المساحة الآمنة، ولكن مع كل مراوغة تظهر مساحة جديدة داخل الفيلم، مساحة تمنح من الجسارة الكافية للصدام، كما يتجسد في الموسيقى كموتيف يوضح تلك النقطة، فالارتطام الأول في حياة منى الشخصية كان بالموسيقى.
التقاطع التاريخي مع الحكي
تخلف تلك النوعية الفيلمية شعوراً مرهقاً بالتاريخ، لأن السردية تسير بشكل مواز أو تتقاطع مع التأريخ لحقبة معينة، مساحة ملتبسة من خلق الدراما داخل الإطار التاريخي، ولكن كردفاني نجح في مراوغة ذلك الارتباك بخلق نوع من الحياد تجاه الأشياء، سواء على مستوى الرصد الخارجي أو الدراما الداخلية، فلم يغرق الفيلم في حمى شاعرية إلى درجة المساس بالإطار الواقعي، بل فضل الوقوف في المنتصف، وموازنة اللغة البصرية بحيث لا تغرق في الرمزية.
ربما كان ثمن ذلك تحول الفيلم ــ في بعض الأحيان ــ إلى لحظات ميلودرامية، أو إلى تسلسل مباشر ومتوقع، مع وجود شخصيات تفتقد للتأسيس الكافي مثل شخصية آجر (جير دواني) ودخوله السريع في السردية نظراً للقفزة الزمنية، بيد أن كردفاني يأخذ مسافته الآمنة لتلافي فخاخ ومناطق شائكة، ليرد كل شيء إلى أصله الإنساني؛ ويتحرك على ذلك الأساس فيرفع من القيمة الحكائية للفيلم، ويقترب من مساحات أكثر حميمية في شكلها الكوني، تتعاطى مع المشاهد السوداني أولاً، ولكنها لا تقتصر عليه، بل تخلق لغة عالمية مفرداتها أكثر حساسية وانفعالاً؛ مما جعل الفيلم يحقق نجاحاً تجارياً متجاوزاً كل التوقعات، فنزوحه نحو الإنساني والفردي حقق تجربة مشاهدة منفتحة على تيمات مجردة على رغم خصوصيتها التاريخية والمكانية، لتصبح التجربة في مجملها أشبه بالأفلام الإيرانية بمعضلاتها ومحدودية إطارها المادي ولكن بثرائها الاجتماعي والإنساني.

مشهد من فيلم: «وداعاً جوليا»
التعاطي مع الموسيقى والأغاني داخل المنتج السينمائي
حافظ المخرج على إيقاع دون الاستعانة بالموسيقى التصويرية إلا في لقطات محدودة، واستبدلها بالأغاني في النصف الثاني من الفيلم، ركز كردفاني على لحظات الصمت ليمرر لحظاته الأكثر عاطفية، زهده الموسيقي إلى جانب لقطاته القريبة المكثفةـ نظراً إلى محدودية المكان الداخلي- حملت الشخصيات مسؤولية أكبر لنقل الشعور إلى المتفرج، والحقيقة أن البطلتين قدمتا أداء جيداً جداً في إطار المساحة المتوفرة لكل منهما، على رغم أن شخصية جوليا- باعتبارها شخصية مركزية في قالب الحدث- لم تطور بالقدر الكافي الذي حصلت عليه منى باعتبارها شخصية مهيمنة على السردية، ولكنها كانت كافية لتقاسم البطولة والمساحة المشتركة وتكوين جانب ضروري ومهم في السرد، لتكشف بمرونة عن مكانها داخل العالم.
والجدير بالذكر أن النهاية- على رغم سهولة توقع تسلسل الأحداث في الثلث الأخير لأنه يتبع متوالية تاريخية مرصودة- فإن المخرج أضاف لمحة ختامية فتحت الفيلم على مساحة أخرى، ليخلق عالماً من ضلع العنف، وينتهي عنده أيضاً، كأنه لم يتحرك، مع الافتتاح بمتوالية ترصد العنف والتخريب، يختم بشخصية آجر مع الفتى الصغير دانيال يرتديان ملابس عسكرية فيما يحمل الفتى الصغير بندقية في يده، كإشارة واضحة أن العنف لم ينته بعد.