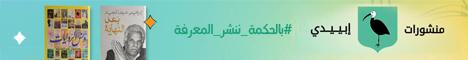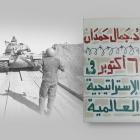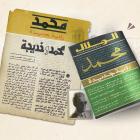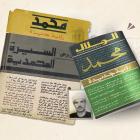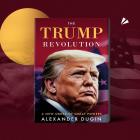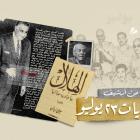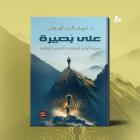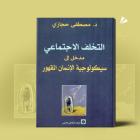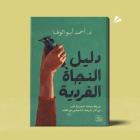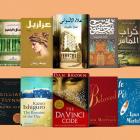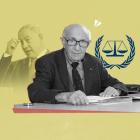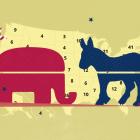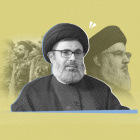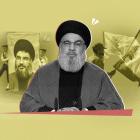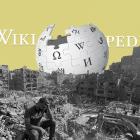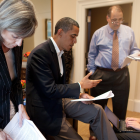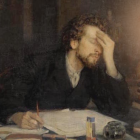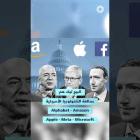مجتمع
ذكرياتي عن ثورة يوليو
نوال السعداوي: من الثورة إلى السجن، أربعون عامًا بين الحلم والهزيمة… وبين الحرية الموعودة والقيود الواقعية.
 صورة تعبيرية (من أرشيف ذكريات 23 يوليو، مقال للكاتبة والروائية نوال السعداوي، نُشر في 1 سبتمبر عام 1992 بمجلة الآداب)
صورة تعبيرية (من أرشيف ذكريات 23 يوليو، مقال للكاتبة والروائية نوال السعداوي، نُشر في 1 سبتمبر عام 1992 بمجلة الآداب)
مقال للكاتبة والروائية نوال السعداوي، نُشِر بمجلة الآداب في 1 سبتمبر عام 1992.
أربعون عامًا مرّت منذ سمعت صوت جمال عبد الناصر لأول مرة يدوي في أذني؟ كنت في العشرين من العمر، طالبة بكلية الطب، شابة طويلة القامة نحيفة الجسم واسعة العينين، أطل على العالم بما يشبه الحلم. أيّ حلم؟ أربعون عامًا مضت من عمري دون أن أدري، خلسة، وكأنما هي أربعون يومًا. وعمري اليوم ليس ستين عامًا، وإنما أنا الفتاة بنت العشرين الممشوقة الجسم، التي لا تلمس الأرض بقدميها حين تخطو خطواتها السريعة، يكاد جسمها يقفز، يطير في الجو، وعيناها مملوءتان بذلك الحلم. أيّ حلم؟
وفي المشرحة جلست، وأمامي جثة رجل مجهول تفوح منها رائحة الفورمالين؛ كان ذلك الشاب الثائر الذي لم يبق منه في خيالي إلا عينان بلون البحر والسماء معًا، حين تذوب السماء ومياه البحر في زرقة داكنة، ثم تذوب الزرقة في خضرة العشب أو الحشائش التي تنبت وحدها على شواطئ البحار، عند مصبات الأنهار حيث تذوب الملوحة في المياه العذبة.
كان يأتي إليّ في المشرحة، ومعه مجلة صغيرة هو الذي يحررها، أطلق عليها اسم الثورة، يناولها لي وهو يثبت عينيه الزرقاوين الخضراوين في عيني. وكان لكلمة الثورة بريق خاص أشبه بوهج الضوء، تمتلئ به العينان ويصعب التحديق فيهما، ومن تحت الضلوع أحس بالخفقة.
في الشرفة البحرية، أول الليل، كان أبي وأمي يجلسان يأكلان الجبنة البيضاء والخيار، وأسمع أبي يلعن الملك والإنجليز. كنت طفلة، وفي إجازة الصيف كنا نسافر إلى بيت جدتي في القرية. أسمعها تحكي عن الملك حين يدخل الحمام ويستحم باللبن، ومن حوله الخدم يدلكون جسمه بالزبدة والقشدة، وأرى الناس في القرية يأكلون المخلل بالخبز الحاف ويبيعون اللبن والزبدة والقشطة في السوق ليستحم بها الملك.
وما إن سمعت بسقوط الملك حتى وجدتني أخرج إلى الشارع أهتف مع الناس: تحيا الثورة! وحينما سمعت صوت جمال عبد الناصر لأول مرة أحسست بالخفقة تحت الضلوع.
كان الشاب الثائر يزورني في المشرحة من حين إلى حين. وما إن تراه زميلاتي حتى تختفي الواحدة وراء الأخرى. كأنما للحب إشعاع خاص يفرض على الآخرين الاختفاء؛ بل إن العالم كله يختفي، ولا يبقى إلا هو وأنا. ناولني المجلة، وفيها مقاله عن جمال عبد الناصر وثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢. كتب فيها يقول: لأول مرة في تاريخ مصر يحكمها واحد من أهلها، ولسوف نطرد الإنجليز ونحرّر القناة ونعيش الحرية والاستقلال.
واليوم، وبعد مرور أربعين عامًا على الثورة وعلى الحب الأول في حياتي، أدرك أن الحب الأول وهم، والثورة خيال أو مجرد حلم. لكن الحلم جزء من الحقيقة، وبغير الحلم لا نعيش حقيقة أفضل، أو حياة أفضل. وكنت غير راضية عن الحاضر، أرى الظلم والفقر والعبودية من حولي؛ فالمجتمع المصري – شأن المجتمعات الأخرى في الشرق والغرب والشمال والجنوب – مجتمع طبقي أبوي في الأساس، تحكمه أقلية قليلة تستولي على خيراته كلها، ولا يبقى للأغلبية من الناس إلا الفتات، وتخضع فيه النساء للرجال حسب العرف والقانون والدين والتاريخ العبودي منذ الفراعنة.
أصبحت الثورة هي حلم حياتي من أجل التحرر من هذا النظام: تحرر الفقراء في قريتي، ومنهم عائلة أبي؛ وتحرر النساء، ومنهن أنا وأخواتي البنات.
وكنت أعشق الفن والكتابة. أول كتاباتي مذكرات طفلة اسمها سعاد، كتبتها وأنا في الثانية عشرة من عمري، تلميذة بمدرسة حلوان الثانوية للبنات. وفي عام ١٩٥٥ تخرجت من كلية الطب بالقاهرة، وتحمست للخدمة في الريف، حيث يعيش الفلاحون والفلاحات في قاع الحياة، يعانون المرض والجهل والفقر: الثلاثي المزمن المعروف.
ألقيت بنفسي في العمل الطبي في قرية طحلة بدلتا النيل قرب مدينة بنها. وكان عملًا جديدًا يجمع بين العلاج والوقاية، والثقافة الصحية. وكان اسم المركز الذي أعمل فيه الوحدة المجمعة، وهي وحدة تجمع بالإضافة إلى المركز الطبي المركز الاجتماعي والمدرسة.
كانت الثورة قد بدأت مشروعًا جديدًا للنهوض بالريف المصري، وأنشأت هذه الوحدات المجمعة للعمل الطبي والاجتماعي والتعليمي في معظم القرى في مصر. وكان يمكن لي أن أعمل بالقاهرة وأعيش حياة المدنية المريحة بالمقارنة مع حياة القرى. لكنني اخترت العمل في الريف، وفي قرية طحلة وفي كفر طحلة بالذات التي هي قرية أبي وجدتي وعماتي الفلاحات.
لم تكن الكهرباء قد دخلت القرية بعد، وكنت أنتقل بين بيوت القرية على دراجة أحيانًا، وأحيانًا أخرى على ظهر الحمار. ثم أصبح للوحدة سيارة بوكس صغيرة لنقل المرضى.
كانت الحياة شاقة، لكني كنت أجد فيها لذةً كبيرة، وكان الحماس يفيض للتفاني في خدمة الفقراء من النساء والرجال والأطفال. أيّ حلم؟!
وكنت أمر على البيوت لأجلس مع الفلاحات والفلاحين وأشرح لهم كيفية الوقاية من مرض البلهارسيا الذي كان يأكل الكبد والطحال في أجساد أكثر من ٩٥٪ من أهل القرى.
وقد صدقت ما كان يقوله جمال عبد الناصر عن الثورة، وعن بناء المجتمع الجديد على نحو أكثر عدالة وأكثر حرية للجميع، وخاصة للطبقات الشعبية الكادحة، وتكسير اللوائح القديمة من أجل الانطلاق نحو مستقبل أفضل.
لكن يبدو أن هذه الخطب لم تصل إلى عقول كثير من المسؤولين حول جمال عبد الناصر، وفي وزارة الصحة كان هناك كبار الموظفين والأطباء الذين لا يؤمنون إلا بالعلاج، ولا يعرفون شيئًا عن الوقاية أو أهمية الثقافة الصحية ورفع الوعي لدى الناس، وخاصة في الريف.
وحدث الصراع بيني وبين هؤلاء الموظفين الذين لم يؤمنوا بالرأي الآخر أو بالديموقراطية؛ لم يعرفوا إلا الأوامر واللوائح القديمة، واعتبروا نشاطي الوقائي وتكسيري اللوائح القديمة نوعًا من التمرد وعدم الطاعة.
وفي عام ١٩٥٦، بعد تأميم قناة السويس، حدث الاعتداء الثلاثي على مصر: اعتداء بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وسمعت صوت عبد الناصر يدوي طالبًا من الشعب المصري الاشتراك في الحرب والمقاومة.
وارتديت الملابس العسكرية، وحولت فناء الوحدة المجمعة إلى ساحة شعبية لتدريب الشباب والشابات على السلاح، وعلى الإسعافات الأولية، والأعمال الطبية التي تتطلبها المعركة.
كان الحماس كبيرًا، وتحولت الوحدة المجمعة إلى خلية نحل، لكن سرعان ما جاءني إنذار من وزارة الصحة بإيقاف كل هذا النشاط الذي أطلقوا عليه اسم النشاط السياسي، وقالوا إن العمل الطبي لا علاقة له بالعمل السياسي.
ثم صدر قرار بنقلي من هذه الوحدة المجمعة إلى وحدة أخرى. وبهذا بدأت أشكك في الخطب التي يلقيها جمال عبد الناصر عن المقاومة الشعبية، أو ضرورة مشاركة الشعب المصري رجالًا ونساءً وشبابًا، والوقوف صفًا واحدًا ضد الاستعمار والرجعية، ومن أجل الاستقلال والحرية.
لم أعد أصدق ما يقوله جمال عبد الناصر عن الحرية، وعن مشاركة الشعب في الحكم، لكني كنت أحس أن كراهيته للاستعمار الأجنبي صادقة.
في بداية الستينات وجدت نفسي طبيبة في أحد المستشفيات العلاجية بالقاهرة. وكنتُ أواصل كتابة القصص والروايات والمقالات أحيانًا، وظلت مشكلتي مع وزارة الصحة قائمة، وامتدت إلى الصحافة والنشر.
كانت هناك إدارة خاصة للرقابة على الكتب والنشر، ولم يكن في إمكاني نشر أي قصة في كتاب أو مجلة أو صحيفة دون أن تمر على هذه الرقابة، وأن يحذف منها الرقيب ما يشاء.
ولم أعد أصدق ما يقوله جمال عبد الناصر عن الحرية، وعن مشاركة الشعب في الحكم، لكني كنت أحس أن كراهيته للاستعمار الأجنبي صادقة، وأنه حاكم وطني يريد أن يحقق أحلامًا كثيرة منها الاشتراكية والوحدة العربية. لكنه كان يريد أن يحقق كل شيء وحده، دون مشاركة الآخرين إلا بعض الموظفين المطيعين الذين يخضعون لآرائه خضوعًا تامًا بلا جدل ولا مناقشة ولا نقد.
وحاول كثير من الرجال حول عبد الناصر أن يجدوا تبريرًا لهذا الاستبداد، وقالوا إن الشعب المصري في حاجة إلى ما أسموه «المستبد العادل». لكني كنت أرى التناقض الصارخ بين الاستبداد والعدل، وبدأ حماسي لعبد الناصر يفتر، وحلم الثورة يتبدد.
وتزايد النفاق في الصحف، واشتدت الرقابة ضراوة، وزادت الهوة بين من أُطلق عليهم «أهل الثقة» و**«أهل الخبرة»**. كان أهل الثقة في معظمهم هم القادرون على النفاق وادعاء الاشتراكية وحب العمال والفلاحين، واحتلوا المناصب الكبرى في الدولة والوزارات والنقابات والاتحادات والإعلام والصحافة والأدب والفن.
وبالطبع لم أكن واحدة من أهل الثقة؛ لأنني أفضل الجدل والنقاش على الطاعة والخضوع للأوامر.
ولكني داومت على الكتابة الأدبية رغم مقص الرقيب، وداومت على النشاط في مجال عملي الطبي، كما دخلت نشاطًا جديدًا في نقابة الأطباء بأمل تحويل مهنة الطب إلى مهنة إنسانية تقدم الصحة للفقراء والفلاحين والفلاحات بلا قيد ولا شرط، كما كان عبد الناصر يخطب ويشتعل حماسًا في الراديو وهو يضغط على مخارج الألفاظ مرددًا العبارة: «بلا قيد ولا شرط، أن تكون الصحة في متناول الجميع بلا قيد ولا شرط».
وكان الأغنياء في مصر فحسب هم الذين يحصلون على الصحة، أو على الأقل على العلاج الطبي ذي المستوى المناسب.
وبدأ الصراع بيني وبين القيادات النقابية من الأطباء الذين احترفوا العمل النقابي والسياسي، والذين جعلوا النقابة سلّمًا للوصول إلى المناصب في الاتحاد الاشتراكي والتقرب من عبد الناصر وأصحاب السلطة. وهكذا وجدت نفسي داخل حلبة الصراع.
وكنت أعترض حين أسمع أن مجلس نقابة الأطباء يتلقى أوامره من وزير الداخلية، وأنه قد أصبح لي «دوسيه» [ملف] في هذه الوزارة باعتباري «مشاغبة» ولا أطيع الأوامر العليا، ولي ميول شيوعية.
كانت كلمة «شيوعية» مثل مرض الجذام، ما إن يصاب بها الإنسان حتى لا يبرأ منها طول العمر.
ولم أنضم في حياتي إلى أي حزب سياسي، شيوعي أو غير شيوعي. حتى الاتحاد الاشتراكي، الذي كان يفرض على الناس بالترهيب أو الترغيب، لم أدخله، ولم أشعر بالرغبة في الاختلاط بأعضائه البارزين، ومنهم بالطبع الموظفون في وزارة الداخلية.
ومع ذلك فقد ألصقوا بي تهمة الشيوعية لمجرد أنني قاومت الانسحاق والخضوع للأوامر العليا؛ ولأنني أيضًا كنت قد تزوجت من طبيب وكاتب اسمه الدكتور شريف حتاتة، قضى في عهد جمال عبد الناصر عشر سنوات في السجن بتهمة الشيوعية (من عام ١٩٥٤ إلى ١٩٦٤).
التقيت به لأول مرة عام ١٩٦٤ بعد أن خرج من السجن، وتزوجنا وواجهنا معًا هذه التهمة التي طاردنا بها رجال عبد الناصر ثم رجال السادات.
وفي يونيو ١٩٦٧ وقعت الهزيمة المنكرة. كان يوم ٥ يونيو بالنسبة لنا وللشعب المصري كله يومًا أسود. وفي يوم ٩ يونيو خرجت مع زوجي شريف حتاتة إلى الشوارع نهتف ضد إسرائيل ونطالب جمال عبد الناصر بالتحقيق والتغيير.
ووعد جمال عبد الناصر الشعب المصري بأنه سوف يبحث أسباب الهزيمة ويعمل على إزالتها. لكنه مات عام ١٩٧٠ قبل أن ينجز ذلك الوعد.
بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ شعرنا بالمرارة والمهانة معًا، حين كنا نرى شكل الجنود المصريين العائدين من سيناء فينتابنا جنون الغضب. شباب كلهم لهم ملامح أبناء عماتي في قريتي بدلتا النيل، ذهبوا إلى الحرب لمواجهة العدو الإسرائيلي، لكنهم لم يحاربوا.
لم يُعطوا الفرصة لإثبات شجاعتهم وكفاءتهم. بل إنه الغدر والفساد والتخبط والفوضى. لم يعرفوا ماذا حدث بالضبط، لكنهم وجدوا أنفسهم في الصحراء العراء والطائرات الإسرائيلية فوق رؤوسهم تضربهم بالقنابل.
قُتل من قُتل، ودُفن من دُفن حيًا أو محروقًا، ومات من مات عطشًا وإرهاقًا في الصحراء. والذين عادوا سيرًا على الأقدام أصبح لهم شكل الموتى الأحياء: أقدامهم تورمت كأقدام الفيلة من السير حفاة على الرمل الأيام والليالي، وعيونهم جحظت من شدة ما رأوا من هول. نظراتهم زائغة، يتطلعون إلى السماء، يخفون رؤوسهم بأيديهم كأنما من قنابل ستسقط كالمطر.
ولم نعد نعرف طعم النوم. قررنا أنا وزوجي شريف السفر إلى جبهة القتال وحمل السلاح. وفي الحلم رأيت نفسي أضرب الأعداء حتى النصر أو أموت ولا أعود أبدًا من الجبهة.
وتركنا طفلينا الصغيرين، وحملنا السلاح والحقيبة الطبية، وذهبنا إلى الجبهة في القنال. اشتغلت في مستشفى للطوارئ تحت الأرض في الإسماعيلية، وذهب شريف إلى بورسعيد.
سقطت إحدى الدانات الإسرائيلية على المستشفى في الإسماعيلية وقتلت سائق السيارة «الجيب» التي كنت أستخدمها في نقل زجاجات الدم لإسعاف الجرحى. وسقطت دانة أخرى كادت تقتلني داخل غرفة الإسعاف تحت الأرض.
على الضفة الأخرى من قناة السويس كنت أرى الأعداء، وعلى الطريق من الإسماعيلية إلى بورسعيد كنت أرى السيارات تحترق، والدانات تمر من فوق رأسي. ومع ذلك كنت كمن يمشي في النوم: لا أعبأ بشيء ولا أرى الخطر.
ثم جاءت إشارة من القاهرة تطلب عودة الأطباء المتطوعين في الجبهة. وعدت إلى القاهرة. وبعد أيام قليلة جاءتني إشارة لمقابلة مسؤول بالداخلية أو المباحث أو المخابرات، لا أعرف بالضبط. وذهبت إلى المكان المحدد، ووجدته مبنى ضخمًا بالقرب من سراي القبة.
دخلت من الباب فاقشعر جسمي من شكل العيون التي تنظر إليّ. وأدخلوني من باب إلى باب، ثم وجدتني في غرفة شبه عارية إلا من كرسي ومكتب. وتركوني هناك ساعة أو ساعتين أو أكثر دون أن يظهر أحد.
وأخيرًا ظهر رجل له ملامح مشدودة بوليسية، وأخذ يسألني السؤال تلو السؤال كأنما هو تحقيق بوليسي:
-
لماذا سافرت إلى الجبهة؟
-
كم قضيت من الأيام؟
-
كم عدد الأطباء معك؟
-
من كان مسؤولًا عن الطوارئ الطبية؟
-
من قابلت أثناء هذه المدة؟
-
كيف سافرت من الإسماعيلية إلى بورسعيد؟ ... إلخ.
في نهاية التحقيق بلغ بي الغضب أشده، وسألت الرجل: لماذا كل هذه الأسئلة التي تشبه التحقيق مع المجرمين؟ هل اقترفت جريمة ما بتطوعي في الجبهة؟ كنت أتوقع نوعًا من الشكر أو التقدير لا هذا التحقيق المهين!
ونظر إليّ الرجل دهشة وقال: ولقد فعلنا ذلك مع كل الأطباء المتطوعين. إنه مجرد إجراء شكلي ليس إلا. فلماذا أنت غاضبة؟!
أدركت أن التطوع داخل مصر غير مطلوب، وأن دولة المخابرات لن تسمح لأحد بالعمل أو المبادرة، وربما هي السبب في الهزيمة.
وهكذا حدث حتى سافرت إلى الجهة الأخرى في الأردن. كان ذلك عام ١٩٦٨. وتطوعت مع الفدائيين كطبيبة تسعف الجرحى في منطقة السلط. كنا مجموعة من الأطباء المصريين، وقد قررنا السفر كوفد من نقابة الأطباء إلى جبهة القتال في الأردن.
كانت فترة محاطة بالخطر، وليس فيها إلا الألم. المدافع وطلقات الرصاص تدوي، وأرى الدم والموت، لكن هذه الأمور كانت أفضل من البقاء في القاهرة والموت البطيء من شدة الحزن.
بعد موت عبد الناصر واعتلاء السادات العرش زادت الأمور سوءًا. سقط بعض رجال عبد الناصر وبقي بعضهم، وأتى السادات برجاله.
بقي السادات في الحكم من ١٩٧٠ حتى ١٩٨١؛ أحد عشر عامًا من المحنة. طاردني رجال السادات، ونجحوا في طردي من العمل، ومصادرة كتبي، وانتهى بي الأمر إلى زنزانة السجن يوم ٦ سبتمبر ١٩٨١.
لم أعرف لماذا دخلت السجن، فأنا كاتبة روائية وطبيبة، ولا علاقة لي بالأحزاب السياسية التي أمر السادات بتكوينها. وكان السادات قد أعلن عن قيام الديموقراطية والتعددية الحزبية. وظهرت بعض صحف المعارضة، وقد كتبت في إحداها مقالًا تحت عنوان: «الشعب هو الذي يكون الأحزاب، وليس الحاكم». ربما كان هذا المقال هو السبب في دخولي السجن.
وفي ٦ أكتوبر ١٩٨١ تم اغتيال السادات بواسطة القوى الإسلامية السياسية التي ساهم في تشجيعها لضرب القيادات الأخرى، ومنها التيار الناصري.
وبعد شهرين تقريبًا من موت السادات أصدر مبارك قرارًا بالإفراج عن المعتقلين، وخرجت من السجن. لكني لم أخرج إلى الحرية تمامًا؛ انتقلت من القائمة السوداء إلى القائمة الرمادية.
نحن الآن في عام ١٩٩٢ – وقد انقضى على ثورة ١٩٥٢ أربعون عامًا – انقضت بإيجابياتها وسلبياتها. لكني أعتقد أن السلبيات أكثر من الإيجابيات، وأن الهزائم أكثر من الانتصارات، وأن الأمة العربية تواجه فترة من التاريخ مظلمة.
الترسانة النووية الإسرائيلية تزداد قوة، في حين تُضرب قوة العرب في كل مكان: ضرب العراق وحرب الخليج، التهديد بضرب ليبيا ثم سوريا، تمزق لبنان، مأساة الشعب الفلسطيني، هيمنة الولايات المتحدة بالسلاح والإعلام، الأزمة الاقتصادية والثقافية، وشاشة CNN.
وأخطر ما في الأمر من حيث الثقافة والأدب هو سيطرة العقلية النفطية أو البترودولار على الأدب والثقافة والفنون، وانتشار التيارات الدينية المتعصبة.
لا توجد حركة نقدية أدبية إلا في حدود هذه السيطرة النفطية، أو سيطرة العقل الغيبي من ناحية، أو العقل الغربي من ناحية أخرى.
وبعد حرب الخليج زادت الأحوال تدهورًا، واستطاعت السلطات الحاكمة أن تضرب كل فرد أو مجموعة وقفت ضد هذه الحرب الكارثة. ولهذا السبب تم القضاء على جمعيات مثل جمعية تضامن المرأة العربية، ومجلة نون التي لم تحصل أبدًا على تصريح بالخروج إلى النور، رغم أنها كانت مبادرة جديدة في عالم الفكر والإبداع وتحرير الإنسان العربي امرأة ورجلًا.
أربعون عامًا من الثورة قد قادت الأمة العربية إلى ما نحن فيه من تدهور وهزيمة. أربعون عامًا قُتلت فيها الحرية والديموقراطية والوحدة تحت شعار الحرية والديموقراطية والوحدة. لكني ما زلت أثق في قوة الشعوب العربية، إن هي استطاعت أن تخرج من القمقم أو السجن الذي تُسجن داخله.