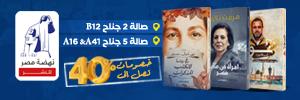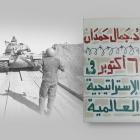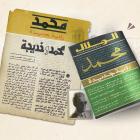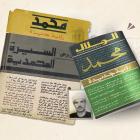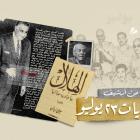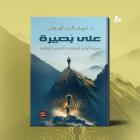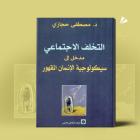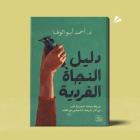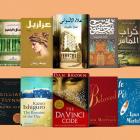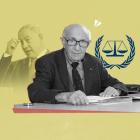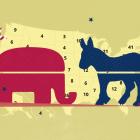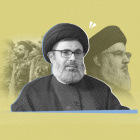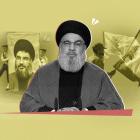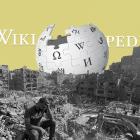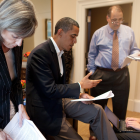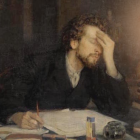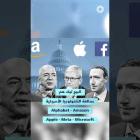مجتمع
ثورة ترامب
فك الارتباط: ثورة صامتة تكتب نهاية الهيمنة الغربية، وكلمة السر التي قد تطيح بالنظام العالمي الذي عرفناه لعقود..
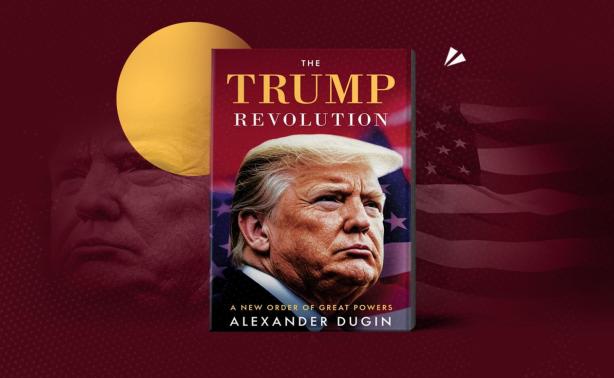 غلاف كتاب «The Trump Revolution: A New Order of Great Powers»
غلاف كتاب «The Trump Revolution: A New Order of Great Powers»
بين أيدينا كتاب وضعه المفكر الاستراتيجي الروسي قبل أشهر قليلة، وأعطاه عنوان «ثورة ترامب»، وقد أضاف عنوانًا فرعيًا توضيحيًا يقول «نظام جديد للقوى العظمى»، هادفًا من وراء ذلك إلى تلخيص رؤيته عن النظام العالمي الجديد الذي حل محل العولمة الليبرالية المهزومة.
في هذا الكتاب جمع دوغين معلوماتٍ عن الأحداث المحورية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، وأثر ذلك الانتخاب على مسار العولمة الليبرالية الذي بدأ في الغرب مباشرةً بعد الحرب العالمية الثانية، بل وحتى قبل ذلك مع الحرب العالمية الأولى ومبادئ وودرو ويلسون الأربع عشرة، التي نصّت على أن الولايات المتحدة هي الضامن والمحرك للديمقراطية الليبرالية العالمية.
لقد وقعت تحولات كبيرة في خريطة العالم من صعود العولمة إبان تفكك حلف وارسو وانهيار الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١.
صراع البر والبحر
يرى دوغين أن انتخاب ترامب المدوي في فترته الثانية يُشكّل ثورةً حقيقيةً، معتبرًا أن هذه الثورة ذات الهوية المحافظة تقف ضد الليبرالية الغربية. يطبق دوغين نظرية «البر والبحر» – التي صاغت التطور الحضاري الذي تقوم عليه الجيوسياسية الكلاسيكية – على الانتخابات الأمريكية، فيتضح منها وجود اتجاهين داخل الخريطة الانتخابية للولايات المتحدة. ففي فترة رئاسته الأولى، صوتت الولايات الداخلية (قوى البر) لترامب، بينما ظلت ولايات الساحلين الغربي والشرقي مواليةً للديمقراطيين (قوى البحر) وداعمةً منافسة ترامب، هيلاري كلينتون. بهذا الشكل، لم يكن التعارض الأساسي بين أمريكا وأوراسيا، بل داخل أمريكا نفسها.
لقد جسّد ترامب قلب الولايات المتحدة المحافظ – جوهر حضارة الأرض – بينما اختارت السواحل التقدمية، المتحالفة مع الليبرالية، العولمة وحضارة البحر. أصبحت الجغرافيا السياسية إقليمية بدلًا من أن تكون عالمية. في ظل ظروف التعددية القطبية الناشئة، أكدت المناطق الساحلية (ريملاند في الجغرافيا السياسية الكلاسيكية) استقلاليتها.
وهذه الأمثلة يمكن أن نجدها أيضًا في نموذج الصين، إذ يقف الداخل الصيني مع الحزب الشيوعي والزعيم «شي جين بينغ»، بينما ما تزال السواحل أكثر تشابكًا في العولمة وتضامنًا مع النظام الرأسمالي العالمي. أما في الهند، وهي دولة حضارية أخرى، فقد وجدت الأرض الداخلية تعبيرها في السياسة المحافظة التي ينتهجها ناريندرا مودي، بينما أصبح راهول غاندي – المدعوم من أنصار العولمة الغربية – رمزًا للبحر.
لكن في الفترة الثانية، كشف دخول ترامب إلى السياسة الكبرى والنضج النهائي لأيديولوجيته، «الترامبية»، عن ظاهرة فريدة تجمع بين أجندة المحافظين القدماء – القومية الشعبوية المهمشة منذ زمن طويل – وتحول غير متوقع في وادي السيليكون، رائد العولمة، حيث بدأ أقطاب التكنولوجيا الفائقة المؤثرون بالتحالف مع السياسة المحافظة. يرافق ترامب سياساته بالشعار الشهير «MAGA لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».
وفق هذا الشعار، لم يعد زعماء الولايات المتحدة ينظرون إليها كموزع عالمي للديمقراطية الليبرالية وضامن لها، بل أُعيد تعريفها كقوة عظمى «تُركز على عظمتها الذاتية وسيادتها وازدهارها». ووفق التفسير النظري لهذا الشعار، فإن الولايات المتحدة ستنظر إلى الأمم الأخرى – جميع الدول في العالم – مكتفية بأن تتمنى لها الخير فحسب، متخلية عن مسؤولية متابعة مصير هذه الدول وأقدارها، ذلك لأن واشنطن ستهتم فقط بنفسها وعظمتها وازدهارها.
وفق هذا التفسير النظري للشعار، يرى دوغين أن المستقبل مع ترامب ومن على نهجه، في هذا النهج لن تعترف الولايات المتحدة إلا بالقوى العظمى الأخرى – والتي تشمل، من وجهة نظر ترامب، روسيا والصين والهند. أما بقية الدول الأخرى فحرة في التصرف كما تراه مناسبًا، سواء بالبحث عن رعاة أو بتأسيس قوى عظمى جديدة قائمة على الهوية الحضارية. يرى ترامب أن هذا هو مفهوم «التعدد القطبي» القائم على أساليب من البرودة والسخرية والقسوة.
عدم اليقين
يستشهد مؤلف كتابنا – ألكسندر دوغين – بمحاضرة ألقاها بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ديسمبر 2024، حملت عنوان «عدم اليقين في النظام الدولي». عدم اليقين مرحلة من مراحل الانتقال من عالم أحادي القطب إلى عالم تعدد الأقطاب، وإن كان من المتعذر الجزم بما إذا كنا بالفعل في عالم متعدد الأقطاب أم لا نزال في عالم أحادي القطب. يبدو أن مقولة الفيلسوف الألماني هايدغر «ليس بعد noch nicht» تعبّر بشكل واضح عن الإشكالية الفلسفية لما نعيشه من انتظار عالم متعدد الأقطاب، رغم أن الدلائل قد تشير إلى أن تعدد الأقطاب آخذ في الصعود، بينما أحادية القطب آخذة في التراجع، لكن الأزمة في أن المعاناة خلال هذه المرحلة الانتقالية تمثل أزمة قاتلة.
ظهور القطب الدولي
في المستقبل القريب – يقول دوغين – لن يكون على الطراز الأمريكي أو السوفيتي، بل سيكون وفق ما فسره باحث صيني بمفهوم «الدولة الحضارية». ويستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف هذا المصطلح كثيرًا. الدولة الحضارية هي حضارة (بنظام متطور من القيم التقليدية وهوية راسخة) منظمة كدولة عظمى، تجذب مجموعات من الأمم والدول التي تشترك في نموذج حضاري مشترك.
ويعدد دوغين في خريطة العالم أربع دول حضارية مكتملة النمو:
- الغرب الجماعي («أرض الناتو»)؛
- روسيا؛
- الصين؛
- الهند.
وهناك أيضًا حضارات أخرى قد تتبع الحضارات الأربع المذكورة، في مقدمتها الحضارات الإسلامية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، التي لم تندمج بعد في صياغة دول عظمى. في المقابل، قد يتفتت الغرب إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.
من غير المرجح أن يقبل ترامب التعددية القطبية، فهو من دعاة الهيمنة الأمريكية. يعتقد ترامب أن المصالح الوطنية يجب أن تأتي أولًا، مدعومةً بالقيم الأمريكية التقليدية. بعبارة أخرى، يمثل نهجه هيمنة يمينية محافظة، في نموذج يطرح معارضةً أيديولوجيةً لهيمنة اليسار الليبرالي. ومن غير المؤكد استمرار تأثير الترامبية على العلاقات الدولية، فقد تؤدي سياساته إلى التسريع بظهور التعددية القطبية، أو قد تؤدي – على العكس – إلى تأجيل بزوغها.
فك الارتباط
أولى علامات السياسة الترامبية ما يسميه دوغين «فك الارتباط»، وهي كلمة مصاغة في الإنجليزية بطريقة حرفية إلى «انفصال الزوجين»، والتي هي عكس «الاقتران»، ويمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من الظواهر، من الفيزياء إلى الاقتصاد. في جميع الأحوال، تشير الكلمة إلى كسر الرابط بين نظامين يعتمدان على بعضهما البعض. بمعنىً عام، وعلى مستوى العمليات الحضارية العالمية، يُعدّ فك الارتباط النقيض المباشر للعولمة.
يشير مصطلح «العولمة» إلى الترابط بين جميع الدول والثقافات وفقًا لقواعد وخوارزميات وضعها الغرب. أن تكون عالميًا يعني أن تكون مثل الغرب الحديث؛ أن تتبنى قيمه الثقافية، وآلياته الاقتصادية، وحلوله التكنولوجية، ومؤسساته وبروتوكولاته السياسية، وأنظمة معلوماته، وتفضيلاته الجمالية، ومعاييره الأخلاقية كشيء عالمي، وشامل، وإلزامي، وغير قابل للتفاوض. وكما قال صموئيل هنتنجتون: «الغرب في كفة... وبقية العالم في كفة أخرى».
قبيل التفكك السوفيتي وبعده، دخلت الصين العولمة في أوائل الثمانينيات في عهد دينغ شياو بينغ. كما هدفت إصلاحات غورباتشوف إلى «الارتباط» بالغرب («الوطن الأوروبي المشترك»)، ثم انضمت روسيا يلتسين بشروط أقل تفضيلًا بكثير في أوائل التسعينيات. وتبعتها الهند لاحقًا.
تسارعت عمليات العولمة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، لكنها بدأت بالتباطؤ والتوقف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان العامل الأهم في هذا التراجع هو مقاومة روسيا بوتين للنظام المعولم. في الوقت نفسه، استفادت الصين إلى أقصى حد من العولمة من خلال استغلال مشاركتها في الاقتصاد العالمي والنظام المالي، وخاصةً نقل الصناعات الغربية إلى جنوب شرق آسيا (حيث كانت تكاليف العمالة أقل بكثير).
لكن الصين شعرت أنها بلغت نهاية حدود مزايا هذه الاستراتيجية. ومن ثم حافظت الصين دائمًا على سيادتها في مجالات معينة، رافضةً الديمقراطية الليبرالية التي يسيطر عليها الغرب، ومُرسخةً سيطرة وطنية كاملة على الإنترنت والمجال الرقمي. وقد تجلى هذا بشكل خاص في عهد شي جين بينغ، الذي أعلن صراحةً أن الصين لا تتجه نحو العولمة المتمركزة حول الغرب، بل نحو نموذجها الخاص للسياسة العالمية القائم على التعددية القطبية.
كما رسخ بوتين بقوة مسار روسيا نحو التعددية القطبية، وبلغت التوترات بين روسيا والغرب ذروتها مع بدء حرب أوكرانيا في 2022، والتي سرعان ما قطع الغرب علاقاته مع موسكو اقتصاديًا (العقوبات)، وسياسيًا (موجة غير مسبوقة من رهاب روسيا)، وفي مجال الطاقة (تدمير خطوط أنابيب نورد ستريم)، والتبادلات التكنولوجية (حظر نقل التكنولوجيا إلى روسيا)، وحتى في المجال الرياضي (سلسلة من عمليات استبعاد تعسفي للرياضيين الروس وحظر مشاركتهم في الألعاب الأولمبية). بعبارة أخرى، ردًا على حرب روسيا في أوكرانيا (يسميها دوغين خطوة وطنية لتأكيد كامل السيادة الروسية)، بادر الغرب إلى فك الارتباط مع روسيا.
مستقبل روسيا في النظام الجديد
وفي ردها على فك الارتباط، يجب على روسيا أن تتعهد برفض ثابت وجوهري للتطبيق العالمي للمعايير الغربية، في الاقتصاد والسياسة والتعليم والتكنولوجيا والثقافة والفن والمعلومات والأخلاق. يؤكد دوغين أن الانفصال لا يعني ببساطة تدهور العلاقات أو قطعها؛ بل إنه أعمق من ذلك بكثير، إذ يستلزم إعادة تقييم الأطر الحضارية الأساسية التي وضعت الغرب لفترة طويلة كنموذج لروسيا، حيث تُعتبر مراحل تطوره التاريخية بمثابة مخطط لا جدال فيه لجميع الدول والحضارات الأخرى، بما في ذلك روسيا نفسها.
لأكثر من قرنين من الزمان – في عهد آل رومانوف، وخلال الفترة السوفيتية (على الرغم من انتقادها للرأسمالية)، وخاصة في عصر الإصلاحات الليبرالية من التسعينيات حتى فبراير 2022 – انخرطت روسيا في الاقتران، ولم تشكك أبدًا في عالمية المسار التنموي الغربي. حتى الشيوعيون، على الرغم من إيمانهم بضرورة التغلب على الرأسمالية، سعوا في البداية إلى بناء نظام اشتراكي اعتمد على التصنيع والتنمية الرأسمالية، وقبول «الضرورة الموضوعية» لتحولات التكوين. حتى رؤية تروتسكي ولينين للثورة العالمية كانت، في جوهرها، عملية اقتران، لأنها كانت أقرب إلى شكل من أشكال «الأممية» يهدف إلى الانحياز إلى الغرب، وإن كان ذلك لتوحيد البروليتاريا العالمية وتصعيد نضالها.
في عهد ستالين، أصبح الاتحاد السوفيتي دولة حضارية بالأساس، لكن ذلك تحقق بالانحراف عن العقيدة الماركسية الصارمة، والاعتماد على نقاط قوته وعبقرية شعبه الإبداعية. وعندما تضاءلت طاقة الستالينية وممارساتها، استأنف الاتحاد السوفيتي انجرافه نحو الغرب تماشيًا مع منطق الاقتران، وبالتالي انهار وتفكك.
مثّلت الإصلاحات الليبرالية في التسعينيات – روسيا يلتسين – دفعة متجددة نحو الاقتران بالغرب، تميزت بالتوجه الأطلسي ونزوع نخبوي روسي نحو تأييد الغرب. حتى في ظل حكم بوتين المبكر، سعت روسيا إلى الحفاظ على الاقتران بأي ثمن، حتى أصبح التناقض لا يمكن التوفيق بين العولمة وتصميم بوتين على تعزيز سيادة الدولة (التي ثبت أنها شبه مستحيلة في إطار العولمة الجارية، لا نظريًا ولا عمليًا). الآن، شرعت روسيا، بوعي وحزم وبلا رجعة، في عملية فك الارتباط. يعني الاقتران الاندماج في الغرب، والاعتراف بهياكله وقيمه وتقنياته كمعايير عالمية، والاعتماد المنهجي عليه، بما في ذلك الرغبة في الانضمام إليه أو اللحاق به أو محاكاته.
من ناحية أخرى، يعني فك الارتباط رفضًا لكل هذه المقدمات، والاعتماد ليس فقط على نقاط قوة روسيا نفسها، ولكن أيضًا على قيمها وهويتها وتاريخها وروحها. يؤكد دوغين أنه على مدار قرون، فإن التغريب متغلغل في روسيا، رغم النكسات المتقطعة التي مني بها. لم يعد التأثير الغربي خارجيًا فحسب، بل أصبح متأصلًا بعمق في المجتمع الروسي. وبالتالي، سيكون فك الارتباط تحديًا بالغ الصعوبة، لأنه يستلزم عمليات معقدة «لتطهير» المجتمع الروسي من التأثيرات الغربية.
الصين والهند والعالم الإسلامي
يزعم دوغين أن روسيا ليست وحدها على طريق فك الارتباط، فجميع الدول والحضارات التي تُفضّل نظامًا عالميًا متعدد الأقطاب تمر بنفس العملية. في طليعة ذلك، فك الارتباط المتوقع بين الصين والولايات المتحدة، الذي يراه مفكرون صينيون أمرًا لا مفر منه. حتى وقت قريب، نجحت الصين في انتزاع فوائد العولمة، لكن الوضع الآن يتطلب إعادة تقييم، والاعتماد على نموذجها الخاص بنجاح التكامل الأوراسي الكبير (بالشراكة مع روسيا) وتنفيذ مبادرة الحزام والطريق.
كما تتبنى الهند التعددية القطبية، وبينما لا يوجد حديث حتى الآن عن فك الارتباط الكامل مع الغرب، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرًا عن مسارٍ لتخليص العقل الهندي من الاستعمار. هذا يعني أنه في هذه الدولة الهندية الحضارية الشاسعة (بهاراتا) لم تعد أنماط التفكير والفلسفة والثقافة الغربية تُعتبر نماذج مطلقة من قِبل الجيل الجديد من الهنود. لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن ذكرى أهوال الاستعمار البريطاني والقهر البريطاني لا تزال حية، ففي نهاية المطاف، كان الاستعمار نفسه شكلًا من أشكال الاقتران.
يزعم دوغين أن الانفصال الشامل جارٍ أيضًا في العالم الإسلامي. يشن الفلسطينيون والجماعات الشيعية المسلمة في المنطقة حربًا حقيقية ضد وكيل الغرب في الشرق الأوسط: إسرائيل. لطالما كان التناقض الصارخ بين القيم الغربية الحديثة والمعايير الدينية والثقافية الإسلامية موضوعًا محوريًا للسياسة المعادية للغرب في العالم الإسلامي، وأهم دولة في العالم الإسلامي يُعوّل عليها في هذا الصدد هي إيران.
وأخيرًا، يُمكننا أن نلاحظ أن الرغبة في الانسحاب داخل الحدود تتجلى بشكل متزايد في الغرب أيضًا. يدعو الشعبويون اليمينيون في أوروبا وأنصار ترامب في الولايات المتحدة علنًا إلى «أوروبا الحصينة» و«أمريكا الحصينة»، أي الانفصال عن المجتمعات غير الغربية، ضد تدفقات الهجرة، وتآكل الهوية، وإلغاء السيادة. حتى في عهد بايدن، وهو عولمي قوي ومؤيد متحمس للحفاظ على أحادية القطب، شهدنا بعض التحركات الواضحة نحو التدابير الحمائية. بدأ الغرب نفسه في الانغلاق، متخذًا خطوات نحو الانفصال. وهكذا، بدأنا بالتأكيد على أن كلمة «الانفصال» ستكون أساسية في العقود القادمة.
يقول دوغين إن ذلك سيعبر عن نفسه بشكل واضح في المستقبل، لكن قلة من الناس يدركون تمامًا عمق هذه العملية والجهود الفكرية والفلسفية والسياسية والتنظيمية والاجتماعية والثقافية التي ستتطلبها من البشرية – مجتمعات ودول وشعوب – للانفصال عن الغرب العالمي. ويمضي بوتين مؤكدًا، بشكل مثالي، قوله: «إن فك الارتباط أو الانفصال لا يحمل فقط عناصر اقتصادية وسياسية، بل هو يحقق استعادة قيمنا وتقاليدنا وثقافاتنا ومبادئنا ومعتقداتنا وعاداتنا وأسسنا، وإحياءها، وإعادة تأكيدها». وفي عبارة بليغة – مثالية ومتفائلة – يختم دوغين رؤيته بالقول: «الانفصال أو فك الارتباط هو التحقيق العملي والخطوة الأكيدة نحو بناء عالم متعدد الأقطاب».