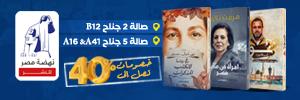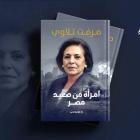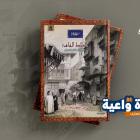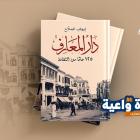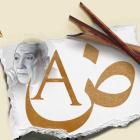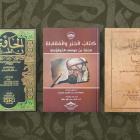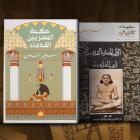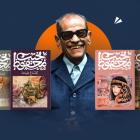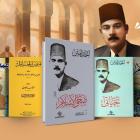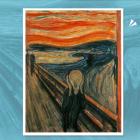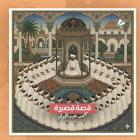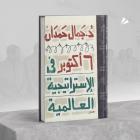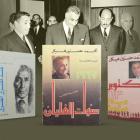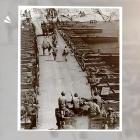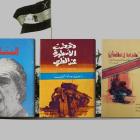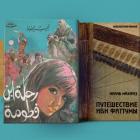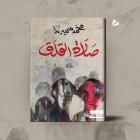معرفة
المثقف المصري وثورة يوليو: من الفعل إلى التبرير إلى الفرجة
بين جذور الإقطاع وأقلام الفلاحين، يرصد المقال ثلاثين عامًا من شراكة القلم والسلطة... من المجد الثوري إلى لحظة فهم ما جرى، بين الحلم والواقع!
 صورة تعبيرية (مقال للكاتب يوسف القعيد نُشر بمجلة الهلال عام 1982 بعنوان: المثقف المصري وثورة يوليو من الفعل إلى التبرير إلى الفرجة)
صورة تعبيرية (مقال للكاتب يوسف القعيد نُشر بمجلة الهلال عام 1982 بعنوان: المثقف المصري وثورة يوليو من الفعل إلى التبرير إلى الفرجة)
نُشِر المقال بمجلة «الهلال» في 1 يوليو 1982.
في الثالث والعشرين من هذا الشهر، تكون ثورة يوليو قد أكملت العام الثلاثين من عمرها. وقد كانت ثورة يوليو هي الثورة الأم للعديد من حركات التحرر في الوطن العربي والشرق الأوسط والعالم الثالث بشكلٍ عام. وثورة يوليو، سواء في سنوات المدّ الثوري أو سنوات الجَزْر اليميني، سواء وهي ثورة فاعلة تقود الفعل الكبير في عالم اليوم، أو عندما تحولت إلى مجرد ردّ فعل، كانت قدوة حقيقية لكل ثورات النصف الثاني من قرننا العشرين هذا.
فكرت طويلًا في البحث والتقصي وراء ما قامت به الثورة بالنسبة للأدب والأدباء، ولكني اكتشفت أن ذلك صعب، فعلاقة المثقف بمصر والحكم في مصر مرت في هذا القرن بالكثير من المراحل. تنوع دور المثقف بين المشاركة الفعلية، والفرجة من بعيد، والقدرة على لعب دور المُبَرِّر، ونظرة اللامبالي واللا منتمي وغير المرتبط بأي قوة من القوى.
اكتشفت أن الحديث عن ثورة يوليو له مدخل واحد، وهو مدخل خاص بي، فمن المؤكد أنه لولا ثورة يوليو ما تعلمتُ أصلًا، وما عرفتُ ذلك العالم السحري الغامض والعظيم الذي يمنحه الحرف المكتوب لمن يتعلمه.
قامت ثورة يوليو وأنا في الثامنة من عمري، وقد شاهدتُ والدي بنفسي قبل قيام الثورة، وهو لا يستطيع المرور من أمام بيت أحد الإقطاعيين في قريتنا، وهو يركب حماره. كان لا بد من نزوله وسيره وراء الحمار حتى يمر من أمام بيته، مع أنه لا يوجد عرف ولا قانون يفرض عليه ذلك، ولكن فقط توجد حالة من الهيمنة الاجتماعية للطبقة التي كان يمثلها هذا الإقطاعي وغيره.
شاهدتُ أيضًا في قريتنا الشجرة الكبيرة التي كان يربط فيها الإقطاعي من يُخالف أوامره، وكان الفلاح يُربط في هذه الشجرة أكثر من يوم في بعض الأحيان.
لستُ باحثًا ولا دارسًا حتى أتكلم الآن عن أثر ثورة يوليو في المثقفين والأدباء، ولكني متأكد أن كثيرًا من الموضوعات الخاصة بعلاقة ثورة يوليو بالثقافة والمثقفين ستُدرَس طويلًا، خاصةً وأنه الآن لا يوجد موقف ضدها، ولا ضد إنجازات جمال عبد الناصر.
في تصوّري، أن أهم إنجازات يوليو الثقافية أن عددًا من الكُتّاب من أبناء الفلاحين والعمال قد أمسكوا بالقلم، وكتبوا بالفعل، أدبًا قدّمهم في صفوف من يكتبون.
وعند الحديث عن أصحاب الأيادي «الخَشِنة» التي أمسكت بالأقلام، أتذكر أن عناق الكلمة المكتوبة في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن، كان مقصورًا على كُتّاب تجري في عروقهم الدماء الزرقاء، إما من عائلات تتحدر من القوقاز أو تركيا، أو من أصول أوروبية. كانت هذه قاعدة أساسية وهامة، وكان من النادر أن تجد في أوساط هؤلاء من أمسك بالقلم بيدٍ خشنة من العمل اليدوي.
ثورة يوليو دفعت إلى ميادين التعليم بأجيال وأسماء، كان من المستحيل أن تتعلم لولا قيام هذه الثورة، وثورة يوليو، باعتبارها أغنية من أغاني الكبرياء المصري في القرن العشرين كله، دفعت في العروق المصرية بدمٍ جديدٍ فعلًا، وكانت عمرًا فاصلًا بحق بين عهدين.
عند قيامها، أعلن نجيب محفوظ إعلانه الشهير، أنه لن يكتب بعد اليوم، لأنه لا يوجد عنده ما يقوله. ومضت سنواتٌ خمس قبل أن يصدر أول عمل أدبي له، وهو الجزء الأول من ثلاثيته الشهيرة المعروفة «بين القصرين».
وعرف الأدب المصري حساسية جديدة، هي حساسية الواقعية الجديدة بعد رومانسية الأربعينات «العالِمة». أصدر عبد الرحمن الشرقاوي «الأرض»، ويوسف إدريس «أرخص ليالٍ»، وقال صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي شعرهما الجديد الذي يحمل رائحة عرق الإنسان العادي.
قابلتُ صلاح عبد الصبور ابتداءً من ديوانه: «الناس في بلادي»، وأحمد حجازي في «مدينة بلا قلب»، وفي المسرح كان هناك سعد الدين وهبة، ونعمان عاشور، وألفريد فرج، وفي الشعر الشعبي قرأنا صلاح جاهين.
مع منتصف الستينات، كان هناك جوٌّ أدبي له علامة محددة، لعب المثقف فيه دورين: دور المشارك في البداية، ثم دور المُبرِّر في المرحلة الثانية، بعد أن حدثت الوقيعة بين الثورة وعقول المثقفين. ولكن من المؤكد أن المثقف كان له دور.
حاولوا ضرب يوليو، وضرب تجربة ومجتمع جمال عبد الناصر الجديد. حاولوا ذلك في 1956، وحاولوه في تجربة الانفصال، وفي حرب 1967.
في السبعينات، كان للمثقف دور جديد في تاريخ ومسيرة يوليو. لعب دور المتفرج من بعيد، حيث أدار ظهره لكل ما في الواقع، وبدأ رحلة إلى أعماق الذات.. نوعٌ من الهجرة إلى الداخل. هناك من هاجر إلى خارج الوطن، ومن رفض الهجرة المثالية، لم يبقَ أمامه سوى الهجرة إلى داخل ذاته.
كانت ثورة يوليو في السنوات الثماني عشرة الأولى من عمرها «فعلًا كبيرًا».. وكانت في الإحدى عشرة سنة الثانية «ردَّ فعلٍ» للفعل الأول. ولما كانت حركة التاريخ تقول: إن التاريخ يتكوَّن من الفعل، وردّ الفعل، ثم الفعل المركب من الاثنين في النهاية، فهل تكتمل الدائرة فعلًا في الزمن الراهن الذي نعيشه الآن..؟
ثلاثون عامًا مرّت على ثورة يوليو، ومع هذا لم يُكتب تاريخها الحقيقي حتى الآن.
ويبدو أن الخطأ الأول الذي ارتكبته الثورة، وهي تهدم أصول المجتمع القديم الذي جاءت لكي تُغيِّره، يبدو أن هذا الخطأ جعل الثورة تشرب من نفس المياه التي سكبتها على الماضي.
في الخمسينات، لقي الناس سعد زغلول، وألصقت الأقلام، بما بها قبل الثورة، كل العيوب والتهم. ولهذا، وجدنا أنه ابتداءً من السبعينات، من أكثر الأعمال رواجًا هو الهجوم على عبد الناصر وكافة إنجازاته.
وفي كل عصر، يوجد عدد كبير من مفكري المناسبات، ومن الكُتّاب المستعدين للعب أي دور، وبأي ثمن، وفي أي اتجاه، لدرجة أن أي شاب يبحث عن قدوة له، لن يجد في تاريخ هذا الوطن زعيمًا إلا وهاجمه من جاءوا بعده.
من المؤكد أن تاريخ ثورة يوليو والمثقف المصري يُشكّل صورة عامة وأساسية من تاريخ علاقة المثقف بالسلطة الحاكمة الوطنية في العالم الثالث. في النصف الثاني من القرن العشرين تبدأ هذه العلاقة، عندما كانت ثورة يوليو مجرد حلم في أذهان المثقفين، واستمرت العلاقة وتنوّعت.
ثلاثون عامًا تمرّ هذه الأيام على ثورة يوليو، وهذه الذكرى تأتي في ظل منعطف تاريخي عام، وحاسم، وخطير. فالطبقة التي قام أبناؤها بهذه الثورة، وهي الطبقة الوسطى، مهدَّدة هذه الأيام بأنها طبقة لا مستقبل لها، وإن كان لها ماضٍ عريق في مصر.
ذلك أن سنوات الانفتاح الاقتصادي في مصر دفعت إلى خريطة المجتمع المصري طبقةً جديدة، هي طبقة «القفز بالمظلات»، الطبقة التي قفزت في خمس سنوات من عمرها من الفقر الرهيب إلى الغنى الفاحش، الطبقة التي تستفز حواس باقي المصريين كلهم.
الطبقة التي ترفع شعارًا: إما أن تمتلك مصر كلها، بمن فيها وما فيها، أو أن تُدمّر مصر كلها.
أعرف أنه من المستحيل أن تُشكَّل ملامح طبقة اجتماعية في سنواتٍ خمس، ولكن الفترة الأخيرة في حياة مصر كانت استثناءً صارخًا لكل القوانين التي عرفتها البشرية في تطورها كله.
إن اللصوص، والمغامرين، والمهربين الذين صعدوا من جوف الأرض، وهدفهم سقف مصر الاجتماعي.. هذه الطبقة هي التي تتهيّأ في هذه الأيام لكي تلعب الدور الذي لعبته الطبقة الوسطى في تاريخ مصر.
نحن الآن في يوليو 1982، وكنتُ أتصور أن اتحاد الكُتّاب، والنقابات المهنية، ونقابة الصحفيين، ووزارة الثقافة، والجمعيات الأدبية، وجامعات مصر، ومراكز البحث العلمي... كنتُ أتصور أن إحدى هذه الجهات ستُنظِّم لقاءً علميًا لدراسة هذه القضية: علاقة صاحب القلم، ابن الكلمة المكتوبة، مع صانع القرار السياسي في هذه السنوات الثلاثين الماضية.
الأمل والعزاء... أن يقوم بها غيرنا في سنوات وأجيال لاحقة لزماننا، الذي لم يصل فيه التاريخ بعد، بكل ما جرى، إلى حالةٍ من التعادل.
أليس مأساويًا أن ينقضي أكثر من نصف أعمارنا، ولا نصل حتى إلى «التعادل»؟!