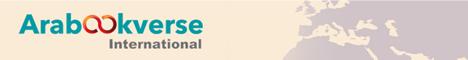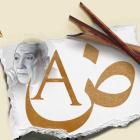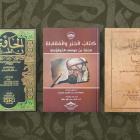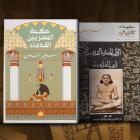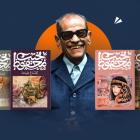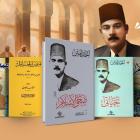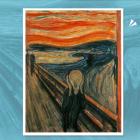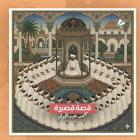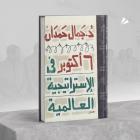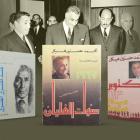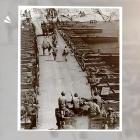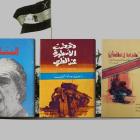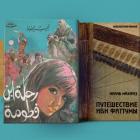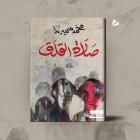معرفة
السلام على أبي الشهداء: صورة الإمام الحسين في المذاهب الإسلامية
رحلة فكرية عبر المذاهب الإسلامية لاكتشاف صورة الإمام الحسين كما رآها كلُّ تيارٍ في ضوء معتقداته وظروفه التاريخية.
 لوحة معركة كربلاء في متحف بروكلين (لوحة سردية دينية تُصوّر مشاهد من معركة كربلاء، التي تُخلّد ذكرى استشهاد الإمام الحسين)
لوحة معركة كربلاء في متحف بروكلين (لوحة سردية دينية تُصوّر مشاهد من معركة كربلاء، التي تُخلّد ذكرى استشهاد الإمام الحسين)
تُرى، هل يمكن اعتبار شخصية الإمام الحسين إرثًا شيعيًّا خالصًا؟ أو شأنًا مذهبيًّا ضيقًا يُستدعى للمناكفات والجدل، في الوقت الذي يُبرَز فيه الأمويون، وهم الخصوم التاريخيون للحسين ولأبيه، بوصفهم قادةً وحكّامًا عِظامًا؟
لن يكون من السهل الإجابة عن هذا السؤال إلا بمحاولة الوقوف على مكانة الحسين في الذهنية الإسلامية ككل، ومحاولة فهم الحسين في آفاق أوسع من الحصريات المذهبية التي لا يتجاوز صداها معتنقي كل مذهب.
تلك المحاولة التي ننشدها للفهم لن تتحقق إلا بمحاولة استدعاء الحسين كما تصوّرته المذاهب الإسلامية (الإباضية، المعتزلة، السنة، الشيعة)، مع التأكيد على وجود ما يمكن أن نُطلق عليه "الزخم الحسيني" في المذهبين الأخيرين.
لكن، قبل الحديث عن ذلك، يظهر سؤال هام: كيف وصلنا إلى تلك اللحظة التي نتحدث فيها عن الإسلام المذهبي؟
من العبث الظنّ بإمكانية اختزال تاريخ نشأة الفرق في بضعة أسطر، لكن دعنا نتحدث عن حدث محوري في تاريخ صدر الإسلام، وهي الفتنة الكبرى التي بدأت باستشهاد الخليفة عثمان بن عفّان، وما ترتّب عليها من تولّي الإمام عليّ الخلافة، وظهور "الشيعة" كقوة سياسية في المجتمع الإسلامي، وظهور "الخوارج" أو "المحكّمة" في المقابل، الذين لم يُبقِ الزمان منهم إلا "الإباضية"، وهي أقل فرق الخوارج تشددًا، وإن كان بعض أهلها ينفي انتسابهم إلى الخوارج، ويعلّل ذلك بأن "الإباضية" فرقة مستقلة بذاتها، تنتسب إلى "جابر بن زيد" و"عبد الله بن إباض".(١)
ولاحقًا، تظهر فرقة المعتزلة بالتوازي مع ظهور مصطلح أهل السنة، كدلالة على الاتجاه الذي يمثّله أهل الحديث، ولاحقًا أتباع المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة.
الإباضية وإدانة الإمام الحسين
في المذهب الإباضي، يبدو الإمام الحسين خافت الحضور بشكل ملحوظ، فما ورد بشأنه قليل، سواء في المدونات التاريخية أو الفقهية والحديثية. فالحسين عند الإباضية، على قلّة ما ورد عنه، لكنه شخصية تاريخية باقتدار، وبالتالي فقد نجت شخصيته – وفقًا للسردية الإباضية – من مظاهر الأسطورية التي سوف تُضفى عليها لاحقًا في مدونات المذاهب الأخرى.
لكن، في الوقت نفسه، فالموقف الغالب في النصوص الإباضية هو البراءة من "الإمام الحسين"، تبعًا للبراءة من أبيه، ومن جهة أخرى فقد بايع معاوية الذي أحدث ما أحدث في الإسلام، وبعض الإباضية ينسب إليه التمثيل بجثة عبد الرحمن بن ملجم.(٢) ولا نعدم بعض الإباضية المحدثين الذين يرون ما حدث في كربلاء مأساة وظلمًا للحسين.(٣)
ومع ذلك، فالفقه الإباضي لا يتحرّج من نقل آراء الحسين وإثبات مكانته قبل أحداث الفتنة، حتى إننا نعثر في المدونة الإباضية على صورة فقهية تؤكد وجود مكانة خاصة للإمام الحسين عند النبي ﷺ، خلاف الصورة التاريخية التي انطلقت من أسس عقدية متمثلة في البراءة بخلفيات سياسية هي أحداث الفتنة. وبالتالي، فالحسين كما يراه الإباضية شخصية عادية من الدرجة الأولى، بل ومدانة بسبب سلوكها السياسي، وهو ما يخالف المذاهب الإسلامية الأخرى التي ترى للحسين مكانة خاصة، يستمدها من نسبه، ومن بلائه في كربلاء، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
المعتزلة ورؤية متوازنة للإمام الحسين
على النقيض من المذهب الإباضي، فقد كان للإمام الحسين، وللعلويين بوجه عام، مكانة واضحة عند المعتزلة، لدرجة نقل ابن أبي الحديد المعتزلي تفضيل بعض المعتزلة الإمام عليّ على سائر الصحابة.(٤)
بديهي، بناء على ذلك، أن نجد للحسين مكانة خاصة عند المعتزلة، على اعتبار أنه حفيد النبي، وابن عليّ وفاطمة، ومن جهة أخرى، فهو شهيد كربلاء الذي وقف في وجه بني أمية، الذين حمل عليهم المعتزلة، بداية من معاوية مؤسس الدولة نفسه، حيث يقول الجاحظ في رسالة النابتة، بعد الحديث عن معاوية، وفي معرض حديثه عن يزيد: «ثم الذي كان من يزيد ابنه، ومن عماله ...... وقتل الحسين عليه السلام في أكثر أهل بيته مصابيح الظلام وأوتاد الإسلام، بعد الذي أعطى من نفسه من تفريق أتباعه والرجوع إلى داره وحرمه...»(٥)
ثم يواصل الجاحظ الحملة على من يدافعون عن الأمويين، وهو في كل ذلك ينطلق من موقف اعتزالي يُجلّ أبناء عليّ، ولا يرى وقارًا لأبناء أمية. ويجعل ابن المرتضى في طبقات المعتزلة الإمام الحسين من الطبقة الثانية من المعتزلة، وينسب له من الأقوال ما يؤيد ذلك.(٦) وفي تفسير «الكشاف للزمخشري»، نجد حضور الإمام الحسين يرتكز على قرابته من النبي، وحبه له، واستشهاده في كربلاء.
الشيعة والإمام الثالث المعصوم
يحتل الإمام الحسين عند الشيعة مكانة بالغة الأهمية، فهو سبط النبي، وابن عليّ، والثالث من الأئمة، وشهيد كربلاء. وتتبع المؤلفات الشيعية، قديمها أو حديثها، يوقفك على قدر الحسين والمكانة التي يشغلها، فأنت تجد الإمام الحسين العابد، والخطيب المفوّه، والمجاهد، والثائر، وأخيرًا الشهيد، وأبو الأئمة، فباقي أئمة الشيعة الاثني عشر من ذرية الحسين، وبالتالي نحن أمام الشخصية المركزية الثانية في الفكر الشيعي.
متعددة هي تجليات الحسين في الموروث الشيعي، وهي تجليات مقدّسة في كل أحوالها، لا تقبل النقد، ولا يخفت الاهتمام بتفاصيلها. فعلى سبيل المثال، كتاب الشيخ محمد الري شهري المسمى «موسوعة الإمام الحسين في الكتاب والسنة والتاريخ»(٦)، والذي جاء في تسعة أجزاء، تجد فيه اهتمامًا بالغًا بكل ما صدر عن الإمام الحسين من تصرفات وأقوال، أو ما تعلّق بحياته من أحداث. ولا ينتهي الأمر بموته، بل يتجدد التتبّع لمصائر قاتليه، ومجالس العزاء، والمراثي التي أُقيمت من أجله.
كذلك تجد مرتضى مطهري – وإن كان أسبق على الري شهري – يخصص كتابه «الملحمة الحسينية»(٧) للحديث عن الإمام الحسين من خلال كربلاء، أو النهضة الحسينية. فالشيعة لا ينظرون إلى كربلاء بوصفها مأساة فقط، وإنما نهضة وانتصارًا معنويًّا للإمام الحسين على بني أمية، الذين ذهبت دولتهم، وبقي آل البيت في نهاية الأمر.
جدير بالذكر أن الشيعة يقيمون ما يسمى بمجالس العزاء للتذكير باستشهاد الإمام الحسين، وقراءة قصة مقتله. وهي مجالس تروج في كل الأوساط الشيعية على اختلافها، وقد وجّه مطهري سهام نقده لخطباء ورجال تلك المجالس، على اعتبار أنهم يشوّهون النهضة الحسينية والإسلام الشيعي.
والحقيقة أن مجالس العزاء وما يُتلى فيها تحتل مكانة خاصة لدى الشيعة، لدرجة وجود كتب متخصصة بما يُقال في تلك المجالس، وكيفية إعداد خطيب المجلس الحسيني. وفي الوقت نفسه، فهي تقدم صورة أخرى للحسين، وهو ما أشار إليه مطهري في كتابه.
لكن، بغض النظر عن صدق أو كذب ما يُقال، فإننا بإزاء صورة شعبية أخرى للحسين، تتراوح ما بين المأساوية المبالغ فيها، والأسطورية التي لا يصدّقها عقل.
السُّنة.. والأوجه المختلفة للحسين
لو نظرنا إلى المؤلفات التي تدور حول الإمام الحسين في التراث السني، لوجدناها أقل من نظيرتها في المذهب الشيعي. ويبدو هذا الأمر منطقيًّا، ويمكن إرجاعه إلى مكانة الإمام الحسين المحورية بالنسبة للمذهب الشيعي. وتجدر الإشارة إلى أن الجدل المذهبي بين السنة والشيعة، بالإضافة إلى تنوّع أهداف التصنيف داخل المذهب السني نفسه، أظهر لنا اليوم صورًا عدة لشخصية الإمام الحسين.
أصبح لدينا الحسين الصحابي، والحسين الصوفي، والحسين الشهيد، والحسين الشعبي، والأخير يُعدّ آخر تجليات شخصية الحسين زمنيًّا، وإن لم يكن التصوّر الوحيد المستقر في العقلية السنية.
وتمدّنا كتب التراجم والتاريخ السنية بصورة مكتملة للحسين كفاعل تاريخي، مثل ترجمته في كتاب «طبقات ابن سعد»، على سبيل المثال، فهو يقدم صورة تاريخية مكتملة لإنسان يعيش كما البشر، دون أي تقديس، مع الإشارة لمكانته من النبي بطبيعة الحال، وإبراز مأساته في كربلاء.
بطبيعة الحال، لم يكن الإمام الحسين بمعزل عن الصراع الأموي الهاشمي، الذي بلغ ذروته باستشهاده في كربلاء. وفي سبيل الدفاع عن بني أمية، فسوف تظهر لنا شخصية الحسين كمثير للفتن بسبب خروجه على يزيد، حتى إن ابن العربي المالكي سيلتمس العذر لقتلة الحسين، ويقول:
«وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جدّه المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذّر من الدخول في الفتن».(٨)
وستجد بعض أنصار تيار السلفية المعاصرة يسلك نفس المسلك التبريري
لم تُقصّر كذلك كتب التراجم الصوفية في الحديث عن الإمام الحسين لتعطينا صورته الصوفية.
وفي كتابي «طبقات المناوي وطبقات الشعراني»، وهما أشهر جوامع التراجم الصوفية، تجد التركيز على أقواله ذات البعد الصوفي، والكرامات التي صاحبت استشهاده.
ونستطيع أن نصل إلى أبعد من ذلك، في الخيال الشعبي المصري، إلى اعتبار الإمام الحسين صاحب مصر ومنقذها وحاميها، وقد عبّر عن تلك الرؤية شاعر مجهول في أبيات راجت بعد نكسة 1967:
«أمدح نَبي زين وآدي سِتّ النِّسا زينَب
لابسه حرير سُندُسي ومن تحت الحرير زينَب
أخت الحسن والحسين السيدة زينب
نَدَه سيدنا الحسين من برزخُه روحي
شوفي اليهود دخلوا مصر وضروحي
لأحارب بروحي.. هاتيلي السيف يا زينب»
إجمالًا، يمكننا القول إن صورة الإمام الحسين عند المعتزلة والإباضية – على قلّة حضورها – أقرب إلى الشخصية التاريخية منها إلى الشخصية المقدّسة، كما نجد عند الشيعة.
وفي الوقت نفسه، نجد أن المذهب السني قد عرف تجليات مختلفة لشخصية "الحسين"، وهي مزيج بين الولاية، والبطولة، والفداء، والحكمة. لكن المؤكّد، برغم كل شيء، أن لكلِّ قومٍ حسينَهم، ولكلِّ مذهبٍ تصوّره، الذي تكوّن بناءً على الأسس الفكرية والسياقات المصاحبة لنشأة المذهب.