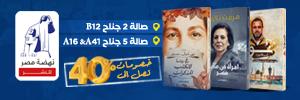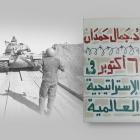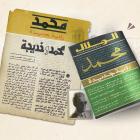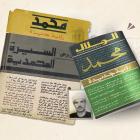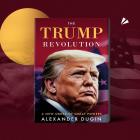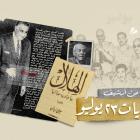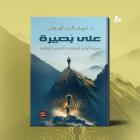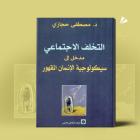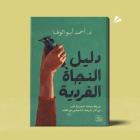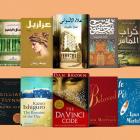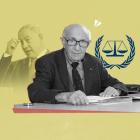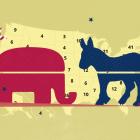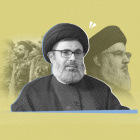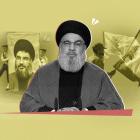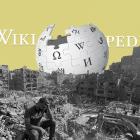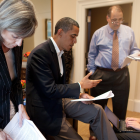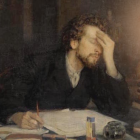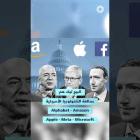مجتمع
الجمعية الأفريقية بالقاهرة: ذاكرة ثورية تتآكل في صمت
الجمعية الأفريقية بالقاهرة.. منارة ثورية تحوّلت إلى أطلال صامتة، وقصة كفاح عابر للحدود ما زالت تبحث عمّن يستعيد ذاكرتها.
 مقر الجمعية الأفريقية بالقاهرة
مقر الجمعية الأفريقية بالقاهرة
شعرتُ بالحزن عند سماعي خبر إغلاق الجمعية الأفريقية بالقاهرة، ولا سيما مع الحجز على مقرها، لكن هذا الحزن لم يكن وليد لحظة الخبر فقط، بل متصلًا بتراجع مكانة الجمعية وتدهور تأثيرها الحيوي الذي امتد منذ زمن، خاصة مع صعود التيار الساداتي إلى السلطة وما تبعه من تغييرات في موقف الدولة تجاه التوجّه الإفريقي، واختفاء وتراجع ورحيل العديد من كوادر الجمعية النشطة الذين كانوا يحرصون على إبقاء شعلة نشاطها حيّة.
كان من المفترض أن تصبح الجمعية متحفًا حيًّا نظرًا لمكانتها الاستثنائية، فقد شكّلت نموذجًا أوليًا لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست لاحقًا عام 1963، إلا أنّ المكان – للأسف – لم يحظَ بالاهتمام المطلوب على مدار عقود.
اللافت أن اسم الجمعية ودورها التاريخي صادفني في العديد من الأبحاث والمقالات، وقد أخبرني صديق من جنوب أفريقيا أنّ الجمعية كانت من بين الأماكن التي يودّ زيارتها أثناء وجوده في القاهرة، لأنه عندما كان في الصف الثانوي قرأ كيف لعب هذا المكان دورًا محوريًا في دعم رفاق مانديلا وروبرت سوبوكوي.
المؤسف أن شعوبًا أخرى كانت تدرك جيدًا مكانة الجمعية وأهميتها التاريخية والسياسية، أكثر مما كان عليه الوعي الشعبي المصري، وهذا ليس تقصيرًا من الشعب، بل نتيجة لعوامل سياسية واجتماعية ممنهجة منذ سنوات تعمل على العداء وتجاهل كل ما هو ممتد إلى القارة الأفريقية.
خلال السطور القادمة، سأقوم بإجراء تعريف بسيط ومختصر للجمعية ووضعها التاريخي لتوضيح أهميتها.
تأسست الجمعية الأفريقية عام 1955، وكان الهدف الأساسي منها تشكيل منصة تجمع بين النشاط السياسي والثقافي، وتنشر الوعي بالقضايا الأفريقية، مع توفير الدعم اللازم للطلاب الأفارقة في القاهرة، لكن سرعان ما تحوّلت إلى هيئة تنسيقية للناشطين المناهضين للاستعمار من كينيا حتى جنوب أفريقيا، وذلك برعاية حكومة جمال عبد الناصر.
كانت من أوائل الوفود القادمة من أفريقيا الاستوائية، فبعد أن حظرت الحكومتان البريطانية والفرنسية «اتحاد شعوب الكاميرون» (UPC)، وجد عدد من الأعضاء أنفسهم أمام ضرورة البحث عن فضاء بديل للعمل السياسي. وقد برز في هذا السياق فيليكس مومييه، الذي قرّر في يوليو 1957 إنشاء مكتب دائم للكاميرون داخل الجمعية الأفريقية. وبعد أشهر قليلة، حذا حذوه البان-أفريكانيست الأوغندي جون كاليكزي، الذي كان خاضعًا لرقابة مشددة من سلطات الاستعمار البريطاني، وكان من المرجّح أن يُعتقل لو سافر جوًا إلى القاهرة؛ لذا اختار عبور الحدود السودانية سرًا متجهًا شمالاً عبر وادي النيل ليستقر في مقر الجمعية كممثل خارجي لـ«المؤتمر الوطني الأوغندي» (UNC).
وخلال ستينيات القرن العشرين، غدت الجمعية الأفريقية فضاءً ثوريًا استضاف نحو أربعة وعشرين حزبًا قوميًا من شرق ووسط وجنوب القارة، وكانت في الوقت نفسه ملاذًا سياسيًا آمنًا للقيادات الثورية الأفريقية، بمن فيهم أميلكار كابرال (مؤسس حركة الاستقلال في غينيا بيساو والرأس الأخضر)، وسامورا ميشيل (مؤسس جبهة تحرير موزمبيق FRELIMO وأول رئيس لموزمبيق بعد الاستقلال)، وأغوستينيو نيتو (Agostinho Neto، مؤسس الحركة الشعبية لتحرير أنغولا MPLA وأول رئيس لأنغولا بعد الاستقلال)، الذين وجدوا في القاهرة مكانًا للجوء والعمل السياسي الحر لكوادر حركاتهم.
كما شارك في الجمعية بعض المندوبين ذوي الخبرة السياسية والتنظيمية، مثل جوشوا نكومو (مؤسس الاتحاد الأفريقي لشعب زيمبابوي) وفوسومزي ميك (عضو مؤسس في المؤتمر الأفريقي الشامل ANC-aligned). وكان الغالبية العظمى من الأعضاء شبابًا في العشرينات من أعمارهم، ومعظمهم من الطلاب المقيمين في القاهرة، الذين وجدوا في الجمعية مدرسة عملية للنضال السياسي والتحرري.
ففي مايو 1958 – على سبيل المثال – تبع الكينيان جيمس أوتشواتا (James Ochwatata) وويرا أمبيثو (Wera Ambetho) خطى كاليكزي عبر وادي النيل، وكان هدفهما في البداية متابعة الدراسة في أوروبا، لكنهما عند وصولهما إلى القاهرة قرّرا تأسيس «مكتب كينيا» داخل الجمعية الأفريقية. وبحلول عام 1960، بدأ هؤلاء يقدّمون أنفسهم على أنهم «المكتب الخارجي للاتحاد الوطني الأفريقي الكيني» (KANU، الحزب الوطني الكيني)، رغم غياب أي صلة تنظيمية مباشرة بالحزب. وقد أتاحت لهم هذه المرونة إمكانية تصوير أنفسهم كممثلين شرعيين للحركة القومية الكينية، وهو ما نجحوا فيه إلى حد بعيد، إذ اعترف مسؤولو الحزب في أبريل 1961 رسميًا بهؤلاء الشباب ككوادر فاعلة واعتبرهم جزءًا أساسيًا من المسار التحرري الكيني.
قدّمت حكومة جمال عبد الناصر منحًا مالية ورواتب ووثائق سفر مكّنت أعضاء الجمعية من المشاركة بحرية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، إلى جانب تنظيم ندوات ومحاضرات لتعزيز المعرفة السياسية والتنظيمية، وتوزيع المنح الدراسية على الطلاب في مختلف أنحاء العالم. كما ساهمت الجمعية في توفير منبر إعلامي للمناضلين الأفارقة للتواصل مع الرأي العام العالمي من خلال نشر مجلات مثل «نهضة أوغندا» و«زيمبابوي اليوم»، التي وُزعت في القاهرة أو هُرّبت إلى المناطق الخاضعة للاستعمار. وأتاح المركز الدبلوماسي للجمعية للأعضاء تقديم تصريحات للوكالات الإخبارية وتبادل المعلومات التي جمعوها عبر شبكاتهم في القارة، مع تشجيعهم على الاستفادة من برنامج «إذاعة القاهرة» الذي بثّ باللغات المحلية موجّهًا إلى شعوبهم.
يوماً ما، أعرب الصحفي أولابيسي أَجالا (رحّال وصحفي نيجيري معروف برحلاته العالمية وتوثيقه لمجتمعات وثقافات مختلفة) عن إعجابه بالجمعية، مشبّهًا إياها بـ«الأمم المتحدة المصغّرة»، بسبب دورها في المساهمة في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الثوار ليس فقط داخل القارة الأفريقية، بل على المستوى العالمي – وخصوصًا في دول الجنوب – من خلال حملات تضامن عابرة للحدود.
ففي يوليو 1959 – على سبيل المثال – نظمت الجمعية «يوم التضامن الأفروآسيوي مع أوغندا»، حيث شارك ناشطون من مختلف المكاتب عبر إذاعة القاهرة للتعبير عن تعاطفهم ضد «الاضطهاد والإذلال» الذي كان يعانيه الأوغنديون تحت الحكم الاستعماري. وبالمثل، عقب اغتيال رئيس الوزراء الكونغولي باتريس لومومبا عام 1961، نظمت الجمعية وقفة احتجاجية استمرت يومين في ميدان التحرير، تخللتها خطب ألقاها مندوبي عدد من الدول الأفريقية.
كشفت الأرشيفات البريطانية عن القلق المستمر الذي كان يساور المسؤولين بسبب تأثير الجمعية الأفريقية وانتشار الأفكار البان-أفريكانيست التي كانت تبثّها. فقد نجحت الجمعية في تحويل التضامن الاجتماعي والسياسي بين الأعضاء إلى قوة فعلية وجبهة موحدة. ومن خلال أنشطتهم في القاهرة وخارجها، تمكّن المناضلون العابرون للحدود من إنتاج دعاية مؤثرة، وجذب الدعم الدولي، وصياغة خطاب موحّد حول حرية الشعوب الأفريقية وحقها في تقرير المصير.
بعد الجمعية الأفريقية، من سيكون الهدف القادم في هذا الإحلال الصامت؟ ومن ستطاله الخطوة المقبلة؟ إن الانحدار التدريجي في الاهتمام بالمواقع التاريخية يجعل استعادة مكانتها ودورها أمرًا صعبًا، ويحوّلها إلى أطلال صامتة تُسهم في فقدان تدريجي للذاكرة الجماعية للشعوب.